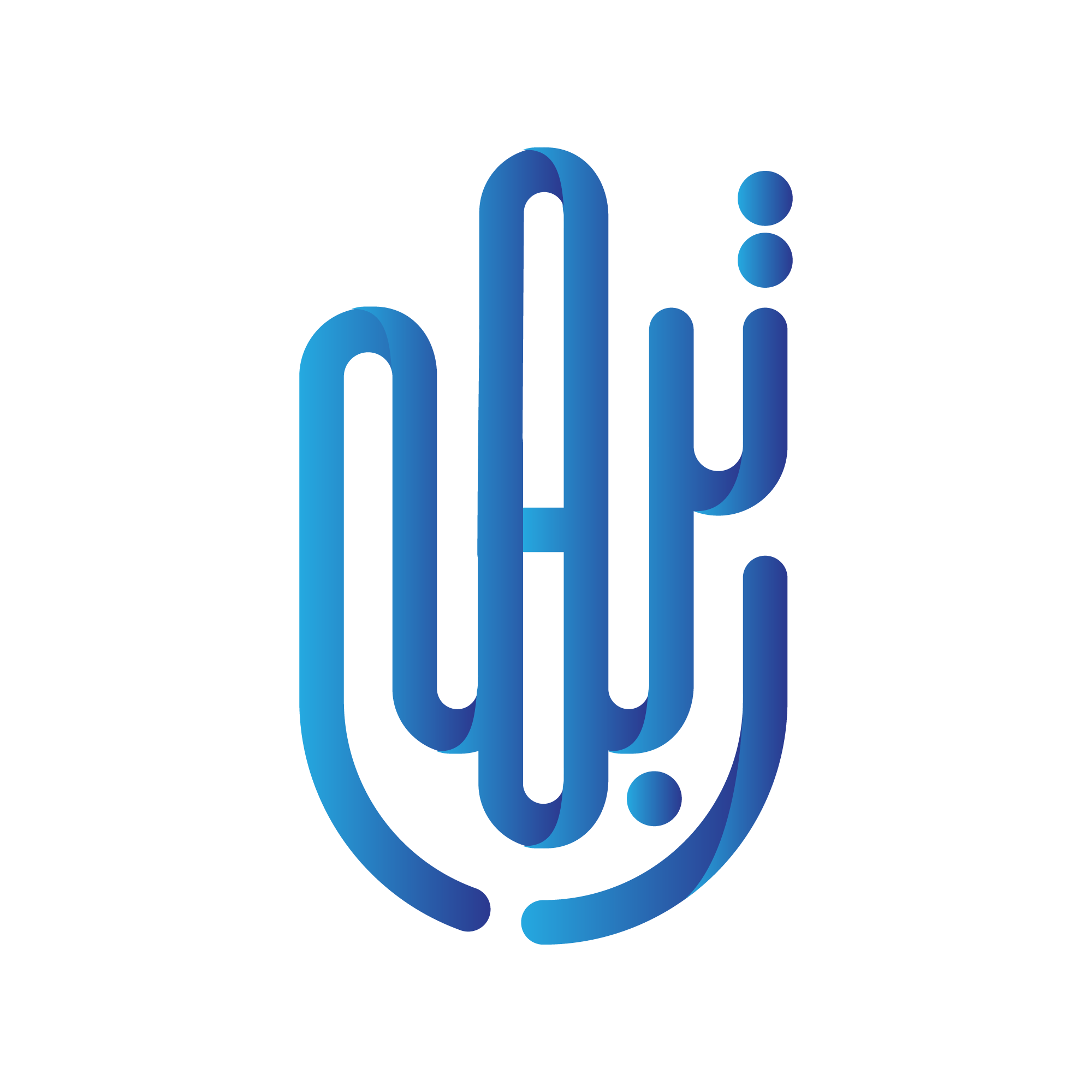لطالما كانت السينما مرآة للمجتمع نجد بها ملامِحنا وأعبائنا وتعثراتنا وتحيي تلك المشاعر بداخلنا فهي كالنافذة المطلّه لعالم خارجي بتدنياته وثقافاته ولايقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تعتبر السينما كهيمنه فكرية وقوة ناعمة تدجج وتصرخ بالرسائل والأفكار التي من شأنها أن تزرع تلك الأصوات والتساؤلات في أذهان روّادها لاسيما في عملٍ غاص في وحل من التشاؤم والبشاعة ففي أولى تجاربي مع المخرج السويدي «لوكاس ماديسون» نقَل لي كل ذلك بصورة طبيعية بدون تلطيف أو تخفيف من حِدة الحدث والقضية فكان ذلك العالم البشع والظالم ينتهش شخصية «ليليا» بالسادسة عشر من عمرها عندما تدير الحياة وجهها لحياتها وأصبحت في مواجهة عالم قاسي ومؤذي يبيح بحدوث تلك الشنائع كالمتاجرة بالأطفال لغايات جنسية رذيله يتصدّع القلب من مشاهدتها أو التفكّر بها ولو للحظة ضاربين عرض الحائط حرمة الإنسان وكل حدود الأخلاقيات الإنسانية والفطرة السليمة، التصدّع الأسري وتضليل الأطفال وغياب الأسرة في وقت مبكر من حياة الإنسان تعني غياب السلطة التوجيهية فتمسي وتصبح شخصيتنا بتمتمة لأسم والدتها وكأنها قارب نجاة لها من عالمٍ ينتهك وينتهز كل مايلامسه في حين غياب والدتها اللعينة خلف مساعي شهوانية وتركها لتلك الإبنة برِفقة صديقها «فولوديا» الذي يعاني من ذات الأمر مِن فقدان للمسؤولية وللرقابة الأبوية وصراعهم الفردي بعالم لايرحم تلك الأرواح، كم تساوي قيمة الإنسان؟ ما الذي يستحق الإبتسام والبهجة؟ تعاصِر شخصياتنا الرئيسية بأحلام تهب فيها الرياح والعتمية والطقس البارد التي تبدو عكس ماتصارعه من حياة مليئة بالكوابيس والظلم والإضطهاد وكأنها لوحة جسّدت كل مخاوفها وآثام والديها فتتلقى بعد ذلك فظاعة خبر كونها بعدم رغبة تحمّل مسؤوليتها من والدتها وخيبة الأمل تعتلي ملامحها فلم تعد للحياة قيمة ولم تعد راغبة بالإستمرار فيُقتل الطموح وتنتهك الإنسانية ولم يتبقى لها سوى رغبتها بالموت إكرامًا لنفسها وروحها البريئة
جاري تحميل الاقتراحات...