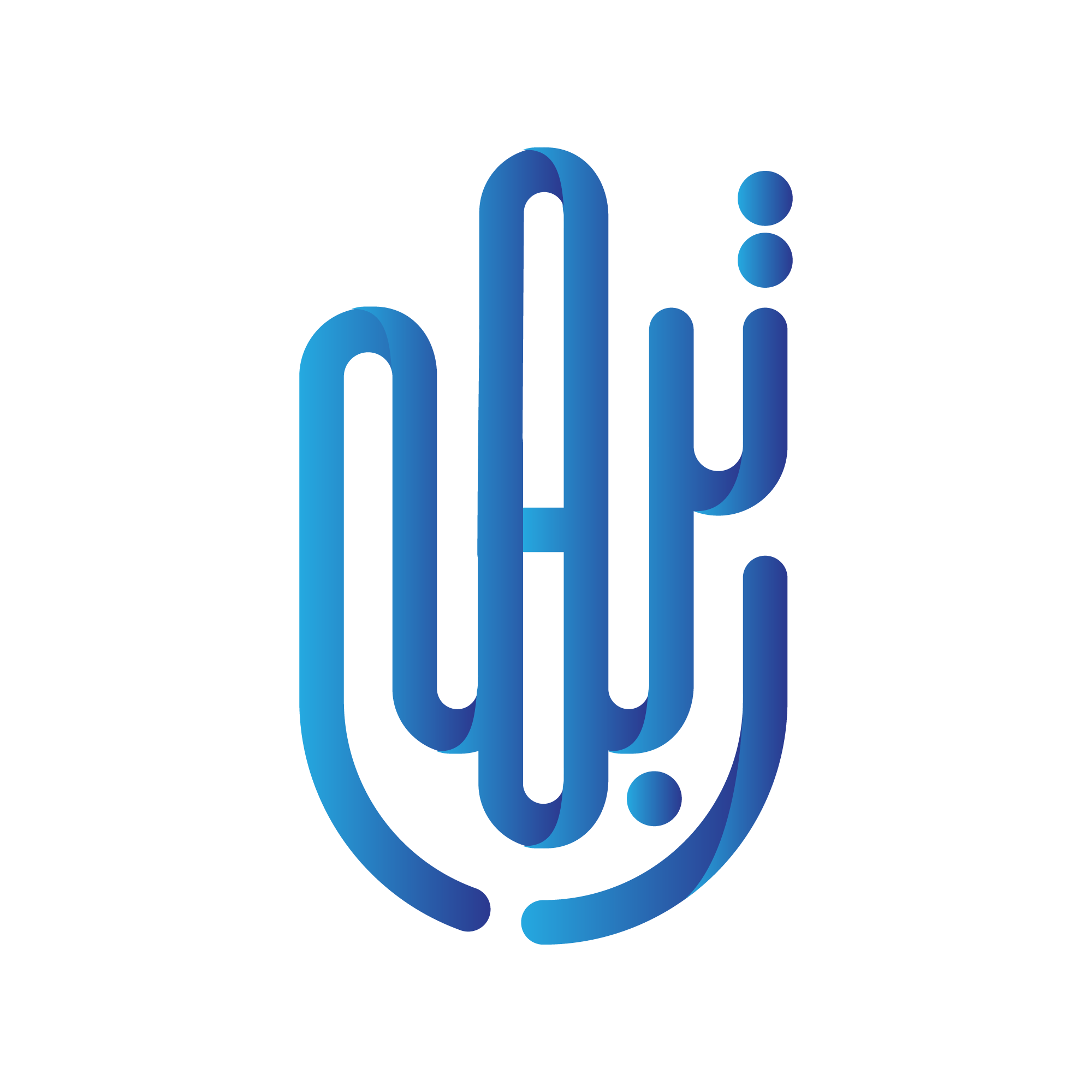أول شاهد يخصّ أبا العلاء حكيم المعرّة، كان إذا أُنشِد بيت أبي الطيب الطائر: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي * وأسمعت كلماتي من به صممُ؛ يقول: أنا ذلك الأعمى، وقال حين فرغ من إملاء «اللامع العزيزي» وقُرئ عليه البيت الآنف الذكر: كأنما نظر المتنبي إليّ بلحظ الغيب!
لاحظوا، لم يلتفت إلى الأصمّ المذكور في الشطر الثاني، ولا إلى اعتداد أبي الطيب بشعره القادر على اختراق الصمم وتحدّي العمى، إنّما سمع نبرةً أخرى حنونة ودافئة، تصله عبر السنين وتفرده بالخطاب، كأنها آصرة تربطه بشاعره الأثير، أو يدٌ انبثقت من الغيب فربتت عليه وواسته في غربته.
وعلاقة أبي العلاء بأبي الطيب تتجاوز علاقة شاعرٍ بآخر، أو أعمى ببصير، أو مُعجَبٍ بمُعجِب، لا شيء يشرحها كالقصة التي تُحكى عن ابن سعد النحوي -أحد رواة المتنبي- وكيف روى بمسمع أبي العلاء -حين كان طالبًا- قصيدةً للمتنبي دالية: أزائرٌ يا خيالُ أم عائدُ * أم عند مولاكَ أنني راقدُ.
لم تكن الدالية مما قرأه ابن سعد على المتنبي، إنما أنفذها إليه وهو بفارس. فلما وصل إلى البيت: أو مَوْضعًا في فناءِ ناحيةٍ * تحملُ في التاج هامةَ العاقِدْ؛ استدرك أبو العلاء مصححًا: أو مُوضِعًا في فتانِ ناجيةٍ، فلم يقبل ابن سعد، ومضى إلى نسخة عراقية، فوجد القول ما قاله أبو العلاء.
قصةٌ بديعة، تقتضي أحد أمرين؛ إما أن أبا العلاء كان يحفظ ديوان المتنبي في صباه بما في ذلك عضدياته التي وصلت محرّفة، أو أنه كان موافقًا لأبي الطيب في مزاجه وطبعه واختياراته إلى درجة أنه لو أجاز له بيتًا، ولم يكن سمعه من قبل، لما وسعه إلا أن يؤدّيه كما صنعه أبو الطيب.
ومن نظر في «سقط الزند» وهو ديوان شباب أبي العلاء، أيقن أنه تتلمذ على شعر أبي الطيب وأخذ منه كما لم يأخذ من شيخ أو كتاب آخر، فمثلًا حين قال: فظنَّ بسائرِ الإخوانِ شرًا * ولا تأمنْ على سرٍّ فؤادا؛ كان ينظر إلى قوله: خليلكَ أنت لا من قلتَ خِلّي * وإن كثر التجملُ والكلامُ.
ومثلًا حين قال: على أم دَفرٍ غضبةُ الله إنها * لأجدرُ أنثى أن تخون وأن تخني؛ كان ينظر إلى قوله: فذي الدارُ أخونُ من مومسٍ * وأخدعُ من كفّة الحابلِ * تفانى الرجالُ على حبّها * وما يحصلون على طائلِ، ومثلًا حين قال: ضجعةُ الموتِ رقدةٌ يستريحُ ال * جسمُ فيها والعيشُ مثلُ السهادِ =
كان ينظر إلى قوله: هوِّن على بصرٍ ما شقّ منظره * فإنما يقظات العين كالحلمِ؛ ومثل هذا كثير، فلو لم يُقتل أبو الطيب في دير العاقول، ولو تقدّم أبو العلاء قليلًا، لربما تتلمذ عليه حقيقةً لا مجازًا، خصوصًا أنه حادث رواته، واستخبر وكيل داره، ومشى في الأرض التي أُقطعها في معرّة النعمان.
لا بدّ أنّ عدم اللقاء هذا أمضّه، لولا أن الديوان واساه، وخاطبه بذلك البيت الكريم الذي يوهم أنّ أبا الطيب نظر إلى المستقبل وابتسم للأعمى المعتزل في داره، ذاك الذي سيرى في شعره مالا يراه المبصرون، ويفهم روحه كما لم يفهمها معاصروه. فيا لها من فكرة! ويا له من عزاء!
شاهدنا الثاني حكاية ذكرها العكبري عن الخالديين، أبي بكر وأبي عثمان، حين أنكرا على سيف الدولة تفضيله شعر أبي الطيب، واقترحا أن يختار ما يشاء من قصائده حتى يعملا أجود منها. حاول صرفهما، وكررا عليه، إلى أن أعطاهما قصيدته: لعينيكِ ما يلقى الفؤاد وما لقي * وللحب ما لم يبق مني وما بقي.
فلما أخذاها قال أبو عثمان لأخيه أبي بكر: ما هذه من قصائده الطنانات فلأي شيء أعطاناها، ثم فكرا فقال أحدهما: والله ما أراد إلا البيتين: بلغتُ بسيف الدولة النور رتبةً * أنرت بها ما بين غربٍ ومشرقِ * إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق * أراه غباري ثم قال له الحقِ؛ فتركا القصيدة ولم يعاوداه.
وأنتم حين تقرأون الحكاية، مدركين ضمنًا أنها موضوعة، لن تملكوا إلا الضحك على اللحيتين الممرغتين في غبار أبي الطيب، والسؤال عن هذه الإهانة الصائبة عمّن صدرت: أمن أبي الطيب الذي قال؟ سيف الدولة الذي اختار؟ الخالديين حين فهما؟ أم الديوان الذي ما كاد يتخلّق حتى شرع يعض قبل اكتماله.
مثل ذلك يُقال عن قصة مماثلة، موضوعة أيضًا، تحكي أنّ أبا العلاء -الذي ما كدنا نتركه حتى رجعنا إليه- حضر مجلس الشريف المرتضى يومًا، وجرى ذكر أبي الطيب، فهضم حقّه، وذكر معايبه، وطعن فيه، مما أحفظ أبا العلاء، فقال: لو لم يكن له من الشعر إلا قوله: لك يا منازل في القلوب منازلُ، لكفاه.
فلما فهم الشريف ما كان يعني غضب، وأمر بسحبه وإخراجه من مجلسه على أسوأ حال، ثم قال لمن حضره: أتدرون أي شيء أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة وللمتنبي أحسن منها ولم يذكرها؟ قالوا: لا، قال: إنما أراد قوله فيها: وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ * فهي الشهادةُ لي بأني كاملُ.
هذه الحكاية كسابقتها، يزعجنا تهافتها لكن تأسرنا دلالتها، وعلى الرغم من اختلاقها للدلالة على ذكاء الشريف المرتضى كما تقترح الدكتورة بنت الشاطئ، إلا أني أريد إدخال مفاجأة عليها تنحرف بها عن وجهها، أريد أن أسأل: ماذا لو كان أبو العلاء يعني حقًا ما قاله؟ ماذا لو كان معجبًا بالقصيدة؟
ألا يمكن أن يكون مفتونًا فعلًا بالمنازل المادية التي تشغل منازل معنوية؟ أليس في شعر شبابه تراكيب عويصة كهذه؟ أتراه سمع بيتها: جمح الزمانُ فلا لذيذٌ خالصٌ * مما يشوب ولا سرورٌ كاملُ، فرأى فيه ترجمة لما مرّ به وما سيمرّ؟ ماذا لو كان الكلام على ظاهره؟ لو لم يكن خلف الأكمة ما وراءها؟
عندها ستتحوّر القصة، وتنصرف من أن تكون شاهدًا على عبقرية الشريف لتكون شاهدًا على عبقرية الديوان، وستكون الشتيمة التي أخرجت المرتضى عن طوره، ودفعته إلى مالا يجدر بأمثاله، صادرةً ليس من فم أبي العلاء، وإنما من عظام أبي الطيب الباردة في دير العاقول. أليس هذا التحوير أظرف وأجدر؟
يوجد تقليد فارسي يتّبعه الإيرانيون، ويُظهر مدى توقيرهم لشاعر قوميتهم حافظ الشيرازي. ينصّ التقليد على أنّ المرء حينما يزمع أمرًا، ويكون محتارًا فيه، يفتح ديوان حافظ كيفما اتفق، وسيجد الجواب في أول بيت تقع عليه عيناه، ولعلّ هذا الفعل كسب من التواتر ما جعلهم يطلقون عليه «فال حافظ».
أكثر من يلجأ إلى «فال حافظ» لا يؤمن بقدرة الشاعر على كشف الحُجُب أو التحدّث من وراء القبر، بل يستفتيه لأنه يعلم أنّ في شعره ما يلامس حالاته وانفعالاته اليومية، وأنّ هذا الشعر -كأي أدبٍ يجمع بين الذاتية والعالمية- قادرٌ على التعليق على ما يمرّ به، تمامًا كما يفعل ديوان المتنبي.
لكن إن كانت الفرس أمة تعامل شاعرها بتوقير ويجاوبها بحنان، فنحن أمة علاقتها بشاعرها أشدّ تعقيدًا، وأكثر حدة، نعلم أنّ لا أحد يشبهه عبقريةً وحرارةً وصدامًا مع السلطة، رغم ذلك لن نعدم بيننا من يلمزه مرةً بالسرقة، ومرةً بالشحاذة، ومرةً بالاستخذاء، وهو هو ألمعيةً وأنفة.
والحقيقة أنني لا أعرف شاعرًا أوسع معارف من المتنبي سوى تلميذه المعري، مع فارق كبير بينهما، فالمعرّي يجاهر بمعارفه ويتكلّف الظهور بصورة الحكيم، بينما أبو الطيب يخفيها ويتكلّف الظهور بصورة الفارس، والعجيب أنه يخفق في كل مرّة، فيظهر الحكيم ويبهت الفارس، ويكون في إخفاقه سرّ نجاحه.
إنه شاعر قمين بنا، نشتمه فيشتمنا، ويغيظنا فنتّهمه، نقارنه بشعراء آخرين ونحن نعلم أنهم أقزام في حضرة شعره. ولأنّ أبا الطيب ابتلي بالحسّاد والطاعنين منذ حياته -وما يزال- كان يلجأ إلى التعريض والشتم غير المباشر، فإذا هذه الشتائم تطال أبناء عصرنا، وتهب الديوان إرادته المستقلّة.
لذا إذا سمعتم أحدًا يحقّر أبا الطيب، أو يتهمه بالشحاذة، أو يساوي بينه وبين أبي فراس، أسألكم بالله لا تردوا، بل افتحوا ديوانه كيفما اتفق، كما يفتح الإيرانيون «فال حافظ»، ولو وقعت أعينكم على بيت من نمط: أفي كل يوم تحت ضِبني شويعرٌ * ضعيف يقاويني قصير يطاولُ، اعلموا أنه «فال أحمد»!
جاري تحميل الاقتراحات...