حاولت تهدئة الصغيرة فلم أفلح، شرحت لها أنّ الهرّة لا بدّ انتقلت إلى مكان آخر كغرفة الطالبات أو القصر، أنّها في حال حسنة تشرب الحليب، وتلعق براثنها، وتنام بعمق، لكنّ شروحي لم تجدِ نفعًا. لم يتوقف بكاؤها إلا حين رجعنا القهقهرى وأريناها هرّتها على الشاشة، حينها فقط اطمأنت وابتسمت.
[٢] ماذا أبكاها؟ لم يكن في اللقطة ما يشير إلى تألّم الهرّة قبل أو بعد الاختفاء، كما أنّ السياق كوميدي بالكامل وتصاحبه جوقة ضاحكة. لقد سبق أن شاهدتْ أفلامًا تناسب عمرها، حيث تتسلل أحيانًا بعض مشاهد الفقد أو الرحيل دون أن تثير ردّة فعل كهذه. لماذا أزعجها اختفاء الهرّة هكذا؟
[٣] لكنّ تلك اللقطة -رغم براءتها وكوميديتها- لا تخلو من عنف، بل إنّ فيها ضروبًا عدّة من العنف: هناك عنفٌ ارتُكِب ضد الهرّة؛ ضد حرّيتها تحديدًا، إذ فجأة، وبهزّة عصا، انعدمت الهرّة، هكذا ببساطة، دون أن تُخيّر أو تُنذر، وكان في فُجَاءة هذا الانعدام ما يُعزز إحساس العنف المرتكب ضدها.
وهناك عنفٌ ارتُكب ضد منطق طفلتي الصوري، ذاك الذي كوّنته على مدى سنتين ونصف، والذي جعلها تفترض أنّ المادة الممتدة في الفضاء تتغيّر أو تتحرك، لكنها لا تنعدم فجأة! العالم محلٌ مخيف، نقضي أعمارنا فيه محاولين فهمه ونظمه في قوانين تحكمه، فإذا كُسِرت أبرز مسلّماتنا من الطبيعي أن نجزع.
[٤] ماذا عنا؟ لماذا نجزع حين يموت أحبابنا؟ هل يمكن لهذا الجزع أن يكون في أصله البدائي، في جذره المدفون تحت التربة، شيئًا يشبه ما أصاب طفلتي حين كدّرها اختفاء الهرّة فجأة؟
[٥] لكنّ علاقتنا بأحبابنا تختلف عن علاقة طفلة بهرّة تراها أول مرة، لقد عشنا معهم أعمارًا طويلة، واعتمدنا عليهم في سدِّ حوائجَ مادية ومعنوية وعاطفية وروحية، وشاركونا ملايين الذكريات، لا بدّ أنّ جزعنا عليهم يختلف عن جزع طفلة على هرّة لا تعرفها!
[٦] عندما يواجه البطل الكميُّ أعداءه، قد يستحضر أبياتًا في الجرأة والإقدام، أو قصصًا عن عنترة وبسطام، أو يتذكّر أحبابه، أو يفرّ ليكر على أعدائه لاحقًا، ومهما تباين فعله أو تعقّد انفعاله، هناك قانون بدائي بالأسفل يحكم جميع هذه الأفعال يُدعى: حارب أو أهرب Fight-or-flight =
حيث يُفرز الأدرينالين، والكورتيزول، وتزداد دقات القلب، كي يتمكن الكائن البشري -أو الحيواني- من الفرار أو المواجهة. هذا القانون يحكم أفعال الكبير والصغير، سواءً بسواء، فهل يوجد شيء مماثل تحت طبقات العزاء التي نتدثر بها حين يموت من نحب؟
[٧] عندما يدفن المرء حبيبًا، يحاول أن يتعزّى وهو عائد إلى منزله، فإن كان مؤمنًا استذكر أنّ هذه الدنيا دار جواز ينتقل منها الأموات إلى ربٍ أرحم بهم، وإن كان ملحدًا أقنع نفسه أنّ أحبابه لن يشعروا بعد الموت بشيء، وإن كان أبيقوريًا تخيّلهم محض ذرّات يهوون في العماء العظيم!
ثم يدخل داره، فيرى الكرسي الذي يجلس عليه والده خاليًا، أو السرير الذي تنام فوقه ابنته مرتبًا، ومهما كان تسليمه بالقضاء والقدر سيجزع، فلقد أخذته ذاكرته على حين غرّة، حيث ما زال يحتفظ بصورة والده أو ابنته ويتوقع رؤيتهما، لن يفهم كيف كانا ثم لم يكونا، لن يزعم أن الفقد بإرادةٍ منه.
[٨] هل يمكن لهذا الجزع أن يكون في أصله البدائي، في جذره المدفون تحت التربة، شيئًا يشبه ما أصاب علياء حين كدّرها اختفاء الهرّة؟
[٩] لكن ما بالي وهذه الأفكار الشقيّة؟ ولماذا الإصرار على حفر التربة للوصول إلى الجذر؟ ها هي علياء تقفز عاليًا فتصرخ أختها مستنجدة، وها هي زوجتي تصعد الدرج فينير كل ما في المنزل. إنها جنة يومية وهبنا الله إياها كي نشكرها، وشقيٌ من لم يكتشف جنته إلا بعد فقدها.
جاري تحميل الاقتراحات...
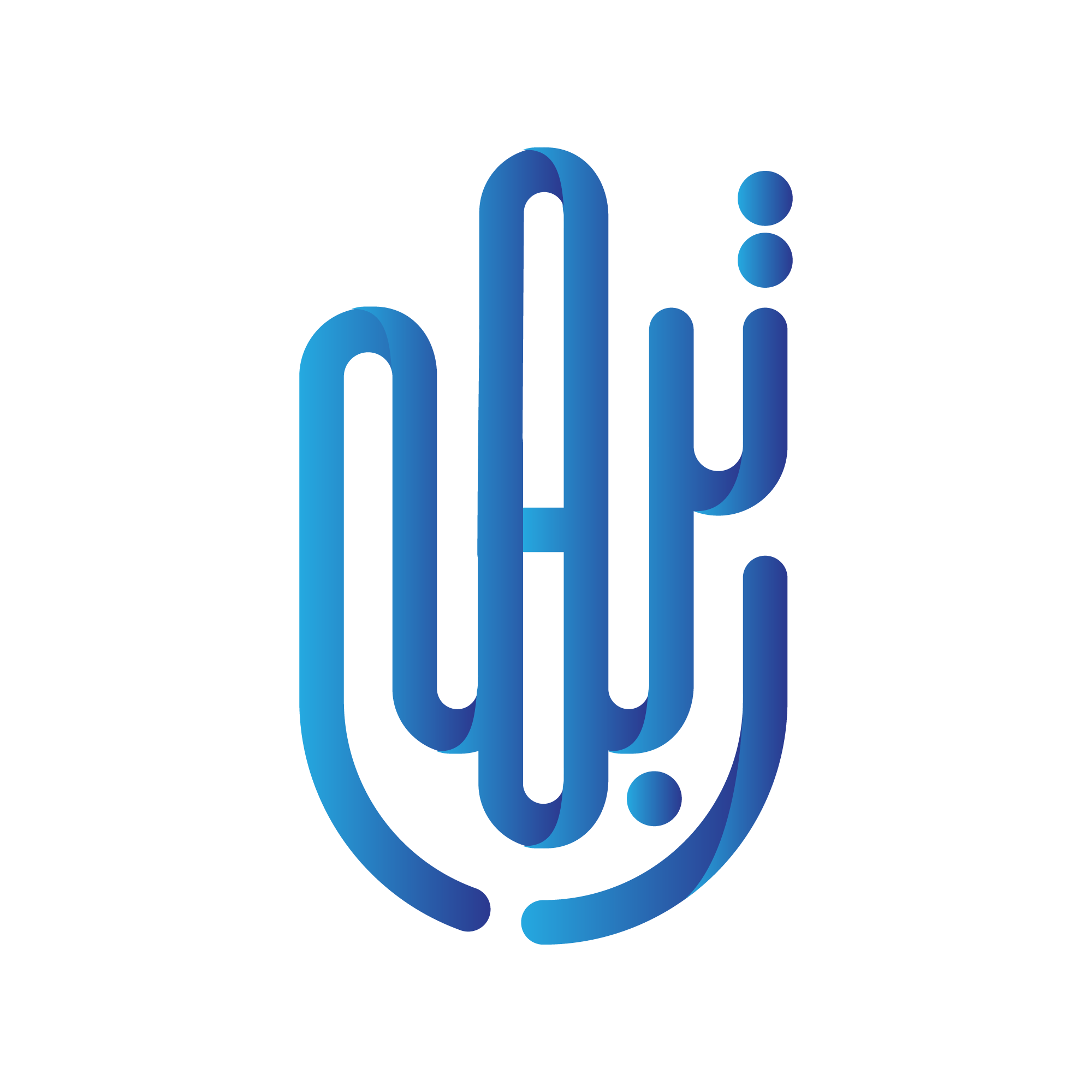

![تأملات
[١] كنت جالسًا بين بُنيّاتي أشتغل، بينما انهمكن في مسلسل عن مدرسة لصغار الساحرات. التفتُّ إل...](https://pbs.twimg.com/media/E6V4_f6UYBgecj2.jpg)