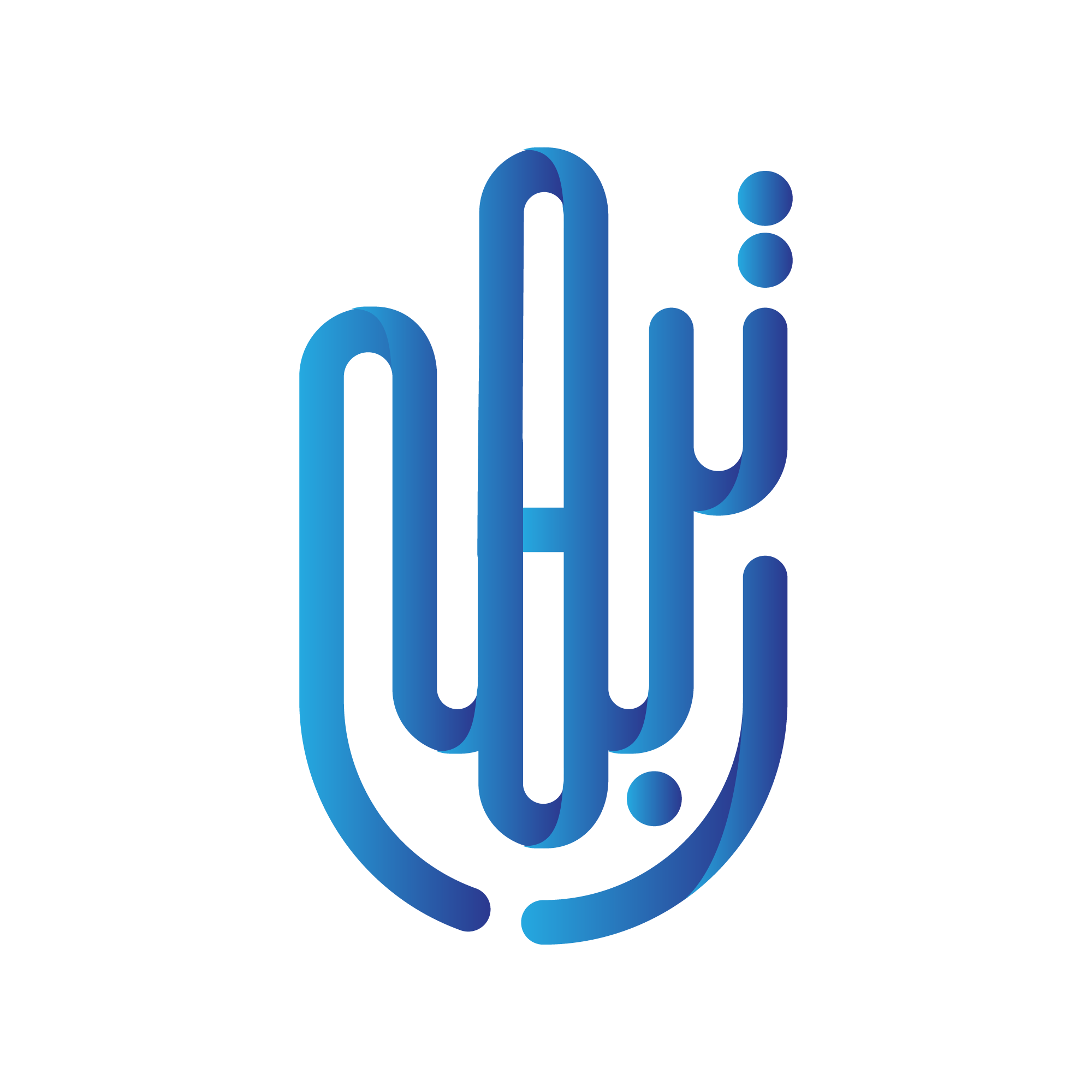الفرح والحزن عارضان سريعا الانبعاث والتواري، وتطلُّب دوام بقاء الفرح وانحجاب الحزن طلبٌ لما يستحيل، وعلى المؤمن أن تتجه همّته لأن تُظلل الطمأنينة والسكينة غالب حياته ويعمد إلى ذلك؛ فهُما أمكن في النفس وأقرّ وأبقى أمدًا، وبه يُعصم المرء من بطَر الفرَح وسكرته من فتك الحُزن ومغبّته.
الأصل في شعورنا "الشعور العادي" لا فرَحَ ولا حُزن.. متى ما أدرك المرء هذا تنعّم بهذا الشعور بل زاد في نفسه بواعث الشعور الحسن لأدنى مثيرٍ لها مما لا يُلتفت إليه من مُستصغر النِعم، فإذا ضُم إليه تحقق موجبات طمأنينة النفس كان في مأمن من فزَعِ روعات النوائب ومن صولة النفس إذا انتشت.
ومن أصول الطمأنينة "الرضا" ومن بواعث الرضا الشعور بعدم الاستحقاق، والنظر للنِّعم على أنها فضلٌ محض، فيتعبّد بدوام الحمد ويطيّب بذلك حياته، فمن لازمه هذا الشعور تنعّم بأدنى النِعم ولازمه شعور الامتنان، فينشغل بحمد الله على نعَمه الحاضرة عن التشوّف لما ينقصه وما فُضّل غيره عليه به.
وكذلك إن من يتحصّل له هذا الشعور الملازم بعدم الاستحقاق والتفضّل المحضّ لله في ما أولى من النِعم، فإنه لا يسد عليه باب أماني النفس في الممنوع عنها وما حُرِمته والتأذي من ذلك وحسب، بل يخفف عليه وطأة سلب النِعم الحاضرة، فهو لا يراها إلا وديعة الله عنده، متى ما شاء أخذها.
والحاصل من هذا أن طيب العيش يتحصّل لا بتعدد أصناف التنعّم، إنما ما يستقر في النفس من الرضا والطمأنينة، ومن رحمة الله بخلقه أن جعل باب الطمأنينة ألزم العوارض للنفوس، وأسهل ما يُمكن تحصيله منها وأصعب ما يُمكن انتزاعه لمن تطلّب بصدق أسبابها.
فأنت ترى من حضرت بين يديه ملذّات الدنيا ولا تُخطئك الوحشة التي بداخله، وترى من سُلب حقّه في العيش وتُطوى أيام البلاء عليه، ومع ذلك يقول: "ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنّتي في صدري؛ أين رُحت فهي معي لا تُفارقني"، ويقول وهو يتقلّب في بلائه: "أنا مثل الغنمة كيفما تقلّبت تقلّبت على صوف!".
جاري تحميل الاقتراحات...