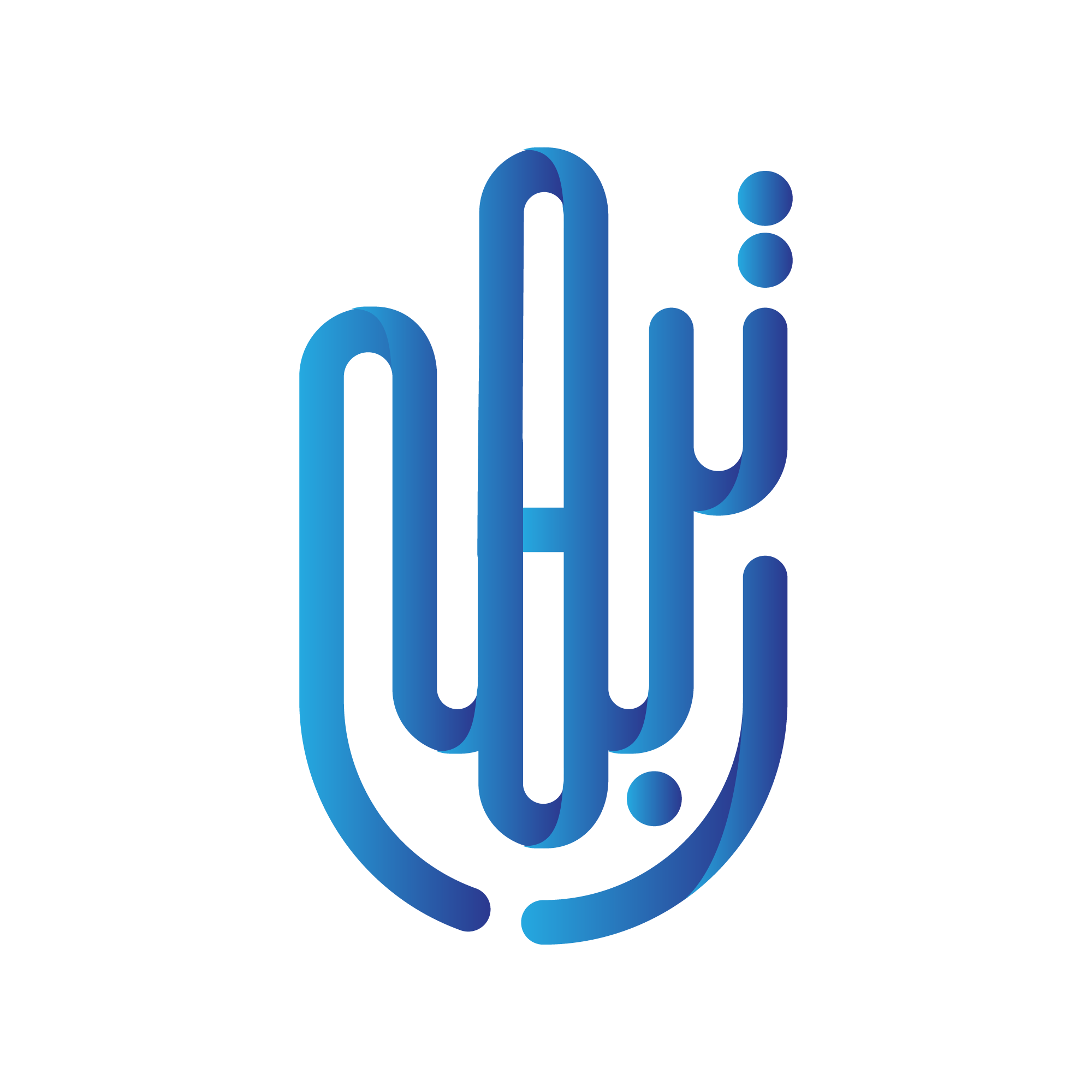#شرح_مقام_الرجاء
ووصف الراجين وهو الرابع من مقامات اليقين
قال الله تعالى: (الله لَطيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ) الشورى: 19 وقال: جلت قدرته: (وَكَاَنَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً) الأحزاب: 43 وقال تعالى: (يَاعِبَاديَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفسهمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ
ووصف الراجين وهو الرابع من مقامات اليقين
قال الله تعالى: (الله لَطيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ) الشورى: 19 وقال: جلت قدرته: (وَكَاَنَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً) الأحزاب: 43 وقال تعالى: (يَاعِبَاديَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفسهمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ الله إن الله يَغْفِرُ الّذُنُوبَ جَميعاً) وقال تعالى مخبراً عن الملائكة الحافين حول عرشه: (وَالْملائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربَّهِمْ وَيَستَغٌفِرون لمَنْ في الأرض) الشورى: 5 وأخبر عزّ وجلّ أن النار أعدها لأعدائه وأنه خوّف بها أولياءه، فقال تعالى: (لَهُمْ مِنْ
فَوْقِهمْ ظُلَل مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخوِّفُ الله بهِ عِبَادَهُ) الزمر: 16 ومثله قول عزّ وجلّ: (واتَّقُوا النار الَّتي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرينَ) آل عمران: 131 وقال تعالى في عفوه عن الظالمين (وَإنَّ رَبَّك لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ)
الرعد: 6
وروي أن النبي ﷺ لم يزل يسأل في أمته حتى قيل له: أما ترضى وقد أنزلت عليك هذه الآية: (وَإنَّ رَبّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للنَّاس عَلى ظُلْمِهِمْ) آل عمران: 135 وفي تفسير قوله تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) الضحى: 5
وروي أن النبي ﷺ لم يزل يسأل في أمته حتى قيل له: أما ترضى وقد أنزلت عليك هذه الآية: (وَإنَّ رَبّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للنَّاس عَلى ظُلْمِهِمْ) آل عمران: 135 وفي تفسير قوله تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) الضحى: 5
قال : لا يرضى سيدنا محمد ﷺ أن يدخل واحد من أمته النار، وكان أبوجعفر محمد بن علي رضي الله عنه يقول: أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب اللّّه تعالى قوله تعالى: (يَاعِبَادي الَّذين أَسْرَفُوا على أَنْفُسهِمْ لاتَقْنطُوا مِنْ رَحْمةِ الله) الزمر: 53 الآية، ونحن أهل البيت نقول
أرجى آية في كتاب الله تعالى: (وَلَسَوْف يُعْطِيكَ رَبُّك فَتَرْضَى) الضحى: 5 وعده ربه عزّ وجلّ أن يرضيه في أمته.
وروي في الخبر الطويل عن أنس رضي الله عنه: أن الأعرابي قال: يا رسول الله من يلي حساب الخلق؟ قال: الله عزّ وجلّ قال: هو بنفسه؟ قال: نعم، قال: فتبسم الأعرابي فقال النبي
وروي في الخبر الطويل عن أنس رضي الله عنه: أن الأعرابي قال: يا رسول الله من يلي حساب الخلق؟ قال: الله عزّ وجلّ قال: هو بنفسه؟ قال: نعم، قال: فتبسم الأعرابي فقال النبي
ﷺ : ممّ ضحكت ياأعرابي؟ فقال: إن الكريم إذا قدر عفا وروي تجاوز، وإذا حاسب سامح، فقال النبي ﷺ : صدق ألا ولا كريم أكرم من الّه عزّ وجلّ هو أكرم الأكرمين، ثم قال عليه السلام: فقه الأعرابي، وفيه أيضاً: إن الله تبارك وتعالى شرف الكعبة وعظمها، ولو أن عبداً هدمها حجراً حجراً ثم أحرقها
ما بلغ جرم من استخف بوليّ من أولياء الله تعالى، قال الأعربي من أولياء الله؟ قال : المؤمنون كلهم أولياء الله تعالى، أما سمعت الله تعالى يقول: (الله وَلِيُّ الَّذين آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ) البقرة: 257، وفي الخبر المفرد عن النبي ﷺ : المؤمن أفضل من
الكعبة، والمؤمن طيب طاهر والمؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة، وفي الخبر عن رسول الله ﷺ أنه نظر إلى الكعبة وقال : ما أشرفك وما أعظمك وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه بتطهير بيته لأوليائه إجلالاِ لهم فشرّف البيت بهم، وفي الخبر عن الله تعالى:
من أهان وليّاً فقد بارزني بالمحاربة وأنا الثائر لوليي في الدنيا والآخرة، وفي أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه: تدري لم فرقت بينك وبين يوسف عليه السلام هذه المدة؟ قال: لا قال: لقولك لإخوته أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لم خفت الذئب عليه ولم ترجني له،
ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له، ومن سبق عنايتي بك أن جعلت نفسي عندك أرحم الراحمين، فرجوتني ولولا ذلك لكنت أجعل نفسي عندك أبخل الباخلين، فالرجاء هو اسم لقوّة الطمع في الشيء بمنزلة الخوف اسم لقوّة الحذر من الشيء، ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجاء في التسمية
وأقام الحذر مقام الخوف فقال: علت كلمته : (يدعون ربهم خوفاً وطمعاً) وقال تعالى: (يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) وهو وصف من أوصاف المؤمنين وخلق من أخلاق الإيمان لا يصحّ إلا به كما لا يصحّ الإيمان إلا بالخوف، فالرجاء بمنزلة أحد جناحي الطير لايطير إلا بجناحيه، كذلك لا يؤمن من لا يرجو من
آمن به ويخافه وهو أيضاً مقام من حسن الظن بالله تعالى وجميل التأميل له، فلذلك أوصى رسول اللّّه ﷺ فقال : لا يموتن أحدكم إلاوهو حسن الظن بالله تعالى لأنه قال عن الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي ماشاء.
وروينا عن يوسف بن أسباط قال: سمعت سفيان الثوري رضي الله عنه يقول في
وروينا عن يوسف بن أسباط قال: سمعت سفيان الثوري رضي الله عنه يقول في
قوله تعالى : (وَأَحْسِنُوا إنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ) البقرة: 195 قال: أي أحسنوا بالله تعالى الظنّ، وكذلك دخل رسول الله ﷺ على رجل وهو في سياق الموت فقال : كيف تجدك؟ فقال أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي، فقال ﷺ : ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى
ما رجا وأمنه مما يخاف، ولذلك قال عليٌّ كرّم اللهُ وجهه للرجل الذي أطار الخوف عقله حتى أخرجه إلى القنوط فقال له: يا هذا أيأسك من رحمة اللهّّ تعالى أعظم من ذنبك؟ صدق رضي الله عنه لأن الإياس من روح الله تعالى الذي يستريح إليه المكروب من الذنوب والقنوط من رحمة الله تعالى التي يرجوها
المبتلي بالذنوب أعظم من ذنوبه وهو أشد من جميع ذنوبه لأنه قطع بهواه على صفات الله تعالى المرجوّة وحكم على كرم وجهه بصفته المذمومة فكان ذلك من أكبر الكبائر وإن كانت ذنوبه كبائر.
وهكذا جاء في التفسير: ولاتلقوا بأيدكم إلى التهلكة قال: هو العبد يذنب الكبائر ويلقى بيده ولا يتوب ويقول:
وهكذا جاء في التفسير: ولاتلقوا بأيدكم إلى التهلكة قال: هو العبد يذنب الكبائر ويلقى بيده ولا يتوب ويقول:
قد هلكت لا ينفعني عمل فنهوا عن ذلك إلا أن الرجاء مقام جليل وحال شريف نبيل لا يصلح إلا للكرماء من أهل العلم، والحياء وهو حال يحول عليهم بعد مقام الخوف، يروحون به من الكرب ويستريحون إليه من مقارفة الذنب، ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء، ومن لم يقم في مقام الخوف لم يرفع إلى مقامات
أهل الرجاء على صحة وصفاء ورجاء، كل عبد من حيث خوفه ومكاشفته عن أخلاق مرجوة من معنى ما كان كوشف به من صفات مخوفة، فإن كان أقيم مقام المخوفات من المخلوقات مثل الذنوب والعيوب والأسباب، رفع من حيث تلك المقامات إلى مقامات الرجاء، بتحقيق الوعد وغفران الذنب وتشويق الجنان وما فيها من
الأوصاف الحسان؛ وهذه مواجهات أصحاب اليمين وإن كان أقيم مقام مخاوف الصفات عن مشاهدة معاني الذات مثل سابق العلم وسوء الخاتمة وخفي المكر وباطن الاستدارج وبطش القدرة وحكم الكبر والجبروت، رفع من هذه المقامات إلى مقام المحبة والرضا، فرجا من معاني الأخلاق وأسماء الكرم والإحسان والفضل
والعطف واللطف والإمتنان، وليس يصحّ أن نخبر بكل ما نعلم من شهادة أهل الرجاء في مقامات الرجاء من قبل أنه لا يصلح لعموم المؤمنين، وهو يفسد من لم يرزقه أشد الفساد فليس يصلح إلا بخصوصة ولا يجديه ولا يستجيب له ولا يستخرج إلا من المحبة ولا محبة إلا بعد نصح القلب من الخوف، وأكثر النفوس
لا يصلح إلاعلى الخوف، كعبيد السوء لا يستقيمون إلا بالسوط والعصا ثم يواجهون بالسيوف صلتاً،ومن علامة صحة الرجاء في العبد كون الخوف باطناً في رجائه لأنه لما تحقق برجاء شيء خاف فوته لعظم المرجوّ في قلبه وشدة اغتباطه به، فهو لا ينفك في حال رجائه من خوف فوت الرجاء؛ والرجاء هو ترويحات
الخائفين، ولذلك سمّت العرب الرجاء خوفاً لأنهما وصفان لا ينفك أحدهماعن الآخر، ومن مذهبهم أن الشيء إذا كان لازماً لشيء أو وصفاً له أو سبباً منه، أن يعبّروا عنه به فقالوا: مالك لا ترجو كذا وهم يريدون ما لك لا تخاف؟ وعلى هذه اللغة جاء قول الله تعالى: (مَا لَكُْم لا تَرْجُونَ للهِ
وَقَاراً) نوح: 13 أجمعوا على تفسيره: مالكم لا تخافون لله عظمة، وهو أيضاً أحد وجهي تفسير قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ) الكهف: 110 أي يخاف من لقائه.
وروي أن لقمان عليه السلام قال لابنه خف الله تعالى خوفاً لا تأمن فيه مكره، وارجه رجاء أشدّ من خوفك، قال: وكيف
وروي أن لقمان عليه السلام قال لابنه خف الله تعالى خوفاً لا تأمن فيه مكره، وارجه رجاء أشدّ من خوفك، قال: وكيف
أستطيع ذلك وإنما لي قلب واحد؟ قال: أما علمت أن المؤمن كذي قلبين يخاف بأحدهما، ويرجو بالآخر؟ والمعنى أن الخوف والرجاء وصف الإيمان لا يخلو منهما قلب مؤمن، فصار كذي قلبين حينئذ ثم إن الخلق خلقوا على أربع طبقات، في كل طبقة طائفة فمنهم من يعيش مؤمناً ويموت مؤمناً، فمن ههنا رجاؤهم
لأنفسهم ولغيرهم من المؤمنين، إذ قد أعطاهم فرجوا أن يتمّ عليهم نعمته وأن لا يسلبهم بفضله ما به بدأهم، ومن الناس من يعيش مؤمناً ويموت كافراً فهذا موضع خوفهم عليهم وعلى غيرهم لمكان علمهم بهذا الحكم ولغيب حكم الله تعالى بعلمه السابق فيهم، ومن الناس من يعيش كافراً ويموت مؤمناً،
ومنهم من يعيش كافراً ويموت كافراً؛ فهذان الحكمان أوجبا رجاءهم الثاني للمشترك إذا رأوه فلم يقنطوا بظاهره أيضاً خوف هذا الرجاء خوفاً ثانياً أن يموت على تلك الحال وأن يكون ذلك هو حقيقة عند الله تعالى، فعلم المؤمن بهذه الأحكام الأربعة ورثه الخوف والرجاء معاً، فاعتدل حاله بذلك لاعتدال
إيمانه به، وحكم على الخالق بالظاهر، ووكّل إلى علام الغيوب السرائر، ولم يقطع على عبد بظاهره من الشرّ، بل يرجو له ما بطن عند الله تعالى من الخير، ولم يشهد لنفسه ولا لغيره بظاهر الخير، بل يخاف أن يكون قد استسرّ عند الله تعالى باطن شرّ، إلا أن حال التمام أن يخاف العبد على نفسه ويرجو
لغيره لأن ذلك هو وجد المؤمنين من قبل أنهم متعبدون بحسن الظن، فهم يحسنون الظنّ بالناس، ويخرجون لهم المعاذير بسلامة الصدور، وتسليم ما غاب إلى من إليه تصير الأمور، ثم هم في ذلك يسيئون الظنّ بنفوسهم لمعرفتهم بصفاتها، ويوقعون الملاوم عليها ولا يحتجون لها لباطن الإشفاق منهم عليهم،
ولخوف التزكية منهم لهم، فمن قلب عليه هذان المعنيان فقد مكر به حتى يحسن الظن بنفسه ويسيء ظنّه بغيره، فيكون خائفاً على الناس، راجياً لنفسه، عاذراً لنفسه، محتجاً لها، لائماً للناس، ذامّاً لهم؛ فهذه أخلاق المنافقين، ثم إن للراجي حالاً من مقامه ولحاله علامة من رجائه، فمن علامة الرجاء
عن مشاهدة المرجوّ، دوام المعاملة وحسن التقرب إليه وكثرة التقرب بالنوافل لحسن ظنّه به وجميل أمله منه، وأنه يتقبّل صالح ما أمر به تفضّلاً منه من حيث كرمه، لا من حيث الواجب عليه، ولا الإستحقاق منّا وأنه أيضاً يكفر سيء ما عمله إحساناً منه ورحمةً من حيث لطفه بنا وعطفه علينا لأخلاقه
السنيّة وألطافه الخفيّة لا من حيث اللزوم له بل من حيث حسن الظنّ به.
كما قال سفيان الثوري رضي الله عنه: من أذنب ذنباً، فعلم أن الله تعالى قدره عليه ورجا غفرانه غفر الله عزّ وجلّ له ذنبه، قال: لأن الله تعالى غيّر قوماً فقال تعالى: (وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذي ظًنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ
كما قال سفيان الثوري رضي الله عنه: من أذنب ذنباً، فعلم أن الله تعالى قدره عليه ورجا غفرانه غفر الله عزّ وجلّ له ذنبه، قال: لأن الله تعالى غيّر قوماً فقال تعالى: (وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذي ظًنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ
أَرْداكُمْ) فصلت: 23 وقد قال سبحانه وتعالى في مثله: (وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً) الفتح: 12 أي هلكى، ففي دليل خطابه عزّ وجلّ أنّ من ظنّ حسناً كان من أهل النجاة،
وقد جاء في الأثر: إن من أذنب ذنباً فأحزنه ذلك
وقد جاء في الأثر: إن من أذنب ذنباً فأحزنه ذلك
غفر له ذنبه وإن لم يستغفر، ومقام الرجاء كسائر مقامات اليقين منها فرض وفضل، فعلى العبد فرض أن يرجو مولاه وخالقه معبوده ورازقه، من حيث كرمه وفضله، لا من حيث نظره إلى صفات نفسه ولؤمه، وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: من سأل الله تبارك وتعالى شيئاً فنظر إلى شيء وإلى أعماله لا
يرى الإجابة حتى يكون ناظراً إلى الله تبارك وتعالى وحده وإلى لطفه وكرمه، ويكون موقناً بالإجابة، ولعمري أن من سأل الله تعالى ورغب إليه في شيء، ورجاه ناظراً إلى نفسه وعمله، فإنه غير مخلص في الرجاء له تعالى لشركه في النظر إليه، وإذا لم يكن مخلصاً لم يكن موقناً، ولا يقبل الله تعالى
عملاً ولا دعاء إلا من موقن بالإجابة مخلص، فإذا شهد التوحيد ونظر إلى الوحدانية فقد أخلص وأيقن، وقد روي عن رسول الله ﷺ : ما من داع دعا موقناً بالإجابة في غير معصية ولا قطيعة رحم، إلا إعطاه الله تعالى إحدى ثلاث؛ إما أن يجيب دعوته فيما سأل، أو يصرف عنه من السوء مثله، أو يدخر له في
الآخرة ما هو خير له، وفي أخبار موسى عليه السلام: ياربّ أي خلقك أنت عليه أشدّ تسخطاً؟ فقال تعالى: من لم يرض بقضائي، ومن يستخيرني في أمر فإذا قضيت له كره ذلك، وفي الخبر الآخر: إنه قال ياربّ أي الأشياء أحب إليك وأيها أبغض؟ فقال سبحانه وتعالى: أحب الأشياء إليّ الرضا بقضائي وأبغضها
إليّ أن تطري نفسك.
وروينا عن النبي ﷺ : يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ قال: فإن لقن الله تعالى العبد حجته قال: ياربّ رجوتك وخفت الناس، قال: لقد غفرت له، وفي الخبرالمشهور : أن رجلاً كان يداين الناس فيسمح لهم ويتجاوز عن المعسر فلقي اللّّه تعالى
وروينا عن النبي ﷺ : يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ قال: فإن لقن الله تعالى العبد حجته قال: ياربّ رجوتك وخفت الناس، قال: لقد غفرت له، وفي الخبرالمشهور : أن رجلاً كان يداين الناس فيسمح لهم ويتجاوز عن المعسر فلقي اللّّه تعالى
ولم يعمل خيراً قط، فقال اللّّه تعالى سبحانه وتعالى: نحن أحقّ بذلك منك قال: فغفر له برجائه وظنه، ثم يتفاوت الراجون في فضائل الرجاء، فالمقرّبون منهم رجوا النصيب الأعلى من القرب والمجالسة والتجلّي بمعاني الصفات مما عرفوه؛ وهذا عن علمهم به وأصحاب اليمين من الراجين رجوا النصيب الأوفر
من مزيده والفضل الأجزل من عطائه يقيناً بما وعد، ومن الرجاء: انشراح الصدر بأعمال البّر وسرعة السبق والمبادرة بها خوف فوتها ورجاء قبولها، ثم مهاجرة السوء ومجاهدة النفس رجاء انتجاز الموعور وتقرّباً إلى الرحيم الودود، ومنه قول أصدق القائلين: (إنَّ الَّذينَ آمَنُواوالََّذينَ هَاجرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبيلِ اللهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ) البقرة: 218 وفسّر رسول اللّّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المهاجرة والمجاهدة فقال المهاجر: من هجر السوء، والمجاهد: من جاهد نفسه في الله تعالى، وأقام الصلاة التي هي خدمة المعبود، وبذل المال سرّاً وعلانيّةً وقليلاً
وكثيراً، وأن لا يشتغل عن ذلك بتجارة الدنيا، كما وصف الله سبحانه وتعالى المحقّقين من الراجين إذ يقول عزّ من قائل: (إنَّ الَّذينَ يَتْلُونَ كِتَابَ الله وأقَامُوا الْصَّلاة وَأنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعلانِيَة يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُور) فاطر: 29
ومن الرجاء
ومن الرجاء
القنوت في ساعات الليل؛ وهو طول القيام للتهجّد، والدعاء عند تجافي الجنوب عن المضاجع لما وقر في القلوب من المخاوف، ولذلك وصف الله الراجين بهذا في قوله تعالى: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الَّليْل سَاجِداً وقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَة وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوي
الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذينَ لا يَعْلمُون) الزمر: 9 فسمّى أهل الرجاء والحذر وأهل التهجّد آناء الليل علماء، وحصل من دليل الكلام: أن من لم يخف ولم يرج غير عالم لنفيه المساواة بينهما، فالرجاء هو أوّل مقام من اليقين عند المقرّبين وهو ظاهر أوصاف الصدّيقين، ولايكمل في قلب عبد،
ولا يتحقّق به صاحبه حتى يجتمع فيه هذه الأوصاف؛ الإيمان بالله تعالى، والمهاجرة إليه سبحانه وتعالى، والمجاهدة فيه وتلاوة القرآن، وإقامة الصلاة، والإنفاق في سبيل الله تعالى، ثم السجود آناء الليل، والقيام والحذر مع ذلك كله؛ فهذه جملة صفات الراجين، وهو أوّل أحوال الموقنين ثم تتزايد
الأعمال في ذلك ظاهراً وباطناً بالجوارح والقلوب عن تزايد الأنوار والعلوم ومكاشفات الغيوب بالأوصاف الموجودة وفصل الخطاب، إن الخوف والرجاء طريقان إلى مقامين؛ فالخوف طريق العلماء إلى مقام العلم،
والرجاء طريق العمال إلى مقام العاملين، وقد وصف الله عزّ وجلّ الراجين مع الأعمال الصالحة
والرجاء طريق العمال إلى مقام العاملين، وقد وصف الله عزّ وجلّ الراجين مع الأعمال الصالحة
لقوة رجائهم بالخوف، تكملة لصدق الرجاء وتتمة لعظيم الغبطة به، فقال تعالى وتقدّس: (وَالّذينَ يُؤتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) المؤمنون: 60 وقال عزّ وجلّ مخبراً عنهم في حال وفائهم وأعمال برّهم: (إنّا كُنَّا قَبْلُ في أَهْلِنا مُشْفِقينَ) (فَمَنَّ اللّّه عَلَيْنَا)
الطور: 26 - 27 وقال عزّ وجلّ: (يُوفُون بِالَّنذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاً) الإنسان: 7 من قبل أن الخوف مرتبط بالرجاء، فمن تحقق بالرجاء صارعه الخوف أن يقطع به دون ما رجا،وقال أهل العربية في معنى قوله تعالى: (قُلْ لِلَّذينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذينَ لا يَرْجُونَ أَيَّام الله)
(الجاثية: 14) أي للذين لايخافون عقوبات الله تعالى، فإذا كان هذا أمره بالمغفرة لمن لا يرجو فكيف يكون غفرانه وفضله على من يرجو، وبعضهم يقول في معنى قوله تعالى: (وَتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ) النساء: 104 أي تخافون منه ما لا يخافون، فلولا أنهما عند العلماء كشيء واحد ما فسّر
أحدهما بالآخر، ومن الرجاء الأنس بالله تعالى في الخلوات، ومن الأنس به الأنس بالعلماء والتقرّب من الأولياء، وارتفاع الوحشة بمجالسة أهل الخير، وسعة الصدر والروح عندهم، ومن الرجاء سقوط ثقل المعاونة على البّر والتقوى، لوجود حلاوة الأعمال والمسارعة إليها، والحثّ لأهلها عليها والحزن
على فوتها والفرح بدركها، ومن ذلك الخبر المأثور من سرّته حسنته وساءته سيئته، فهو مؤمن، والخبر المأثور: خيار أمتي الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤوا استغفروا لأن المؤمن على يقين من أمره وبصيرة من دينه، والخوف والرجاء وصف الموقن بالله تعالى فهو إذا عمل حسنة، أيقن بثوابها لصدق
الوعد وكرم الموعد، وإذا عمل سيئة أيقن بالكراهة لها، وخاف المقت عليها لخوف الوعيد وعظمة المتوعد من قبل أن دخوله في الطاعة، دخول في محبة الله تعالى ومرضاته.
📚من كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي
📚من كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي طالب المكي
جاري تحميل الاقتراحات...