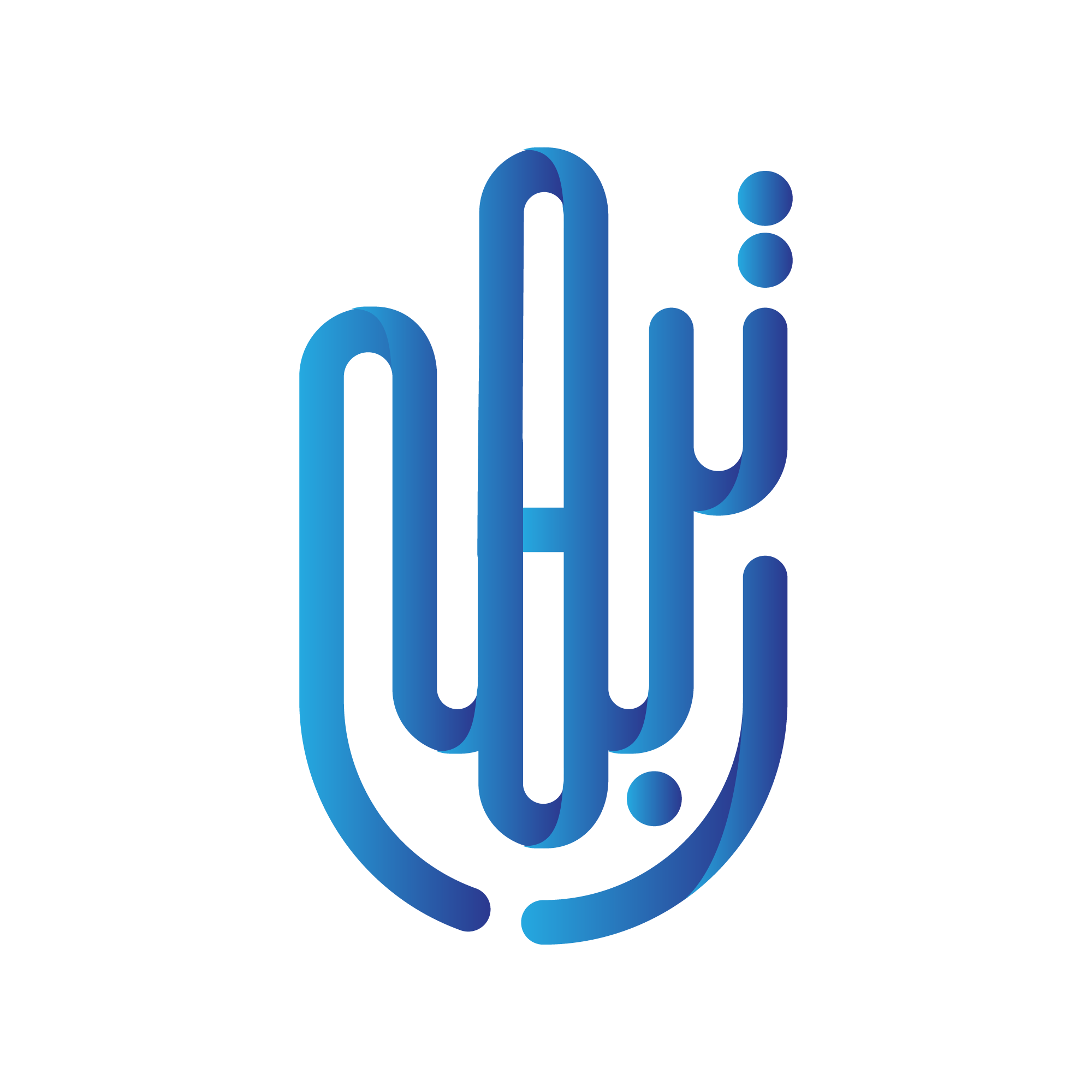الثقافة
الطبيعة
قضايا اجتماعية
الأنثروبولوجيا
حفظ البيئة
الدراسات الاجتماعية
حفظ البرية
الثقافات الأصلية
فيُسْتَقبلون استقبال الأبطال، في مهرجان بهيج، يتلقّى فيه أولئك الفتية الاحترام والتصفيق من رجال القبيلة ونسائها.
لأيّ شيء يُقامر أولئك الفتية بحياتهم في سبيله؟!
وما الفائدة من صيد أسدٍ لا يؤكَل لحمه، ولا يُستفاد منه؟
ما الشيء الذي حملهم على هذه المجازفة الخطيرة؟!
وما الفائدة من صيد أسدٍ لا يؤكَل لحمه، ولا يُستفاد منه؟
ما الشيء الذي حملهم على هذه المجازفة الخطيرة؟!
أجوبة هذي الأسئلة تكشف عن ستورٍ للنفس الإنسانيّة، التي تتلهّف أن يقول لها الناس: "إنّ لك عندنا قدْرًا ومكانة"، تتلهّفُ لذلك حدَّ المقامرة بحياتها!
لا يعدو أن يكون أولئك الفتية الخمسة أكثرَ من باحثين عن التقدير والمكانة، اللتَيْن فرضت القبيلة شروطَهما وإطارهما، في صيد الأسود، وجرّها إلى القبيلة، إعلامًا لأهلِها بفتوّتهم وقوّتهم وصلابتهم.
تبدو هذه "المكانة" أصعب ما يمكن أن يتنازل عنه الناس، هي نفسُها التي تجعل من خسارة المرء نصف ثروته في البورصة أخفّ عليه من انتشار فضيحةٍ له؛ ينحطّ على إثْرها رصيده الاجتماعي، فيعيش أبدَ دهْرِه حبيس ازدراء الناس وتحقيرهم.
صحيح أنّ لكلّ امرئ قيمةً خاصّة به، يحرص على تنميتها في حياته؛ لكنّ الإنسان مبتلًى بإحساس ضاربٍ في أعماقه: أنّ تقيِيم هذه القيمة لا يصدُر من داخله، ولكن من شعور الآخرين تجاهه.
هذا الوضع المجنون يؤرّخ حالةً متطرّفة من سبل تحصيل التقدير والمكانة، ففي ذهنيّة المبارز أنّ السبيل الأوحد لردّ الاعتبار -مهما كان الخطأ سخيفًا- هو بالقتال، وأنَّه بدون هذه المبارزة سيكون فاقدًا لتلك المكانة، وأنّ حياةً بدون مكانةٍ لا تستحق أن تعاش!
يتحرّك الإنسان وَفْقَ ما يحقق هذه المكانة، والبيئةُ التي يعيش فيها هي من تحدّد معايير هذه المكانة، وطلّةٌ يسيرةٌ على تويتر؛ تُنْبِئُك بهولِ ما نحن بصدده:
لا يشكّ أحد أن هذه المناظر: مناظر مستورَدة، وردتنا في جملة ما تصدّره الثقافة الغربيّة ؛ وتلقّفها عبيدُهم في جملة ما تلقّفوه؛ فكان كما ترون من هذه المناظر القذرة المنحطّة.
ولا يشك أحدٌ أنّ خَنَثَ أولئك القوم هيّأ أرضيّةً صالحةً لتتشكّل وَفْق ما تمليه الثقافة الغربيّة:
-حالة دينيّة متدنّيّة (انزياح لمركزيّة الدين، ما تجده يقف عند الأشياء ويسأل: هذا حلال أم حرام؟ بل يزدري من يتوقّف عند ذلك أصلًا).
-حالة فكريّة/نفسية تبعيّة (تأليه للغرب؛ فهو لا يكاد يفعل شيئًا إلّا وله من الغرب برهان).
-حالة من غياب المعنى (تِيه وضياع ممتد، يعيش حياته بمعزل عن إجابات الأسئلة الكبرى: من أين أتينا؟ وما المطلوب منّا في حياتنا؟ وإلى أين المصير؟ .. يردمُ كلَّ هذه الأشياء العظيمة: هيجانُ الإصرار على اللذة الحيوانيّة المجرّدة).
فكانت نتيجة هذه الثلاث: اختراب المعايير، وضياع الهُويّة، واغترابٌ عن قيم المجتمع الأصيلة.
تتداخل مسبّبات هذه الأرضيّة الرخوة، وتتعقّد، ولكنّ أبرز ما يمكن أن يشكّلها:
-الانهزام النفسي تجاه التفوّق الغربي المادّي؛ لأنّ هنالك مشكلة -أصلًا- في إدراك موقع المادّة من سلّم الأولويّات.
-الانغماس في المنتجات الغربيّة (أفلام، مسلسلات، برامج، ...): التي لا تنبعثُ إلّا بعد أن يُنفَخَ فيها من روح قيم أهلِها ومبادئهم، فكان أن تبخّرت -تحت ظلالها- مبادئُ، وتتسلّلت أخرى جديدة.
*الحديث عن هذه الآلة الإعلاميّة أوسع من أن يُخْتَزل بِذِكْرٍ عارض، ولعلّنا نُفْرِغ له سلسلةً خاصّة في قابل الأيّام.
-العائلة البليدة: القائمة على وَهَمٍ تربوي، يظنّ بأنّ مَهمّة العائلة مع ابنهم هي: تحقيق رَغَباتِه، وتزجية وقته بما يضمن بَهْجَتَه.
ويشهد التاريخ، أنّه متى ما ضعف سُلطان الأسرة على الأبناء: ضعف في المجتمع جانبه الأخلاقي.
وقد عزّز من حالة الخواء الداخلي: إمكانيّة صنع مجتمعات افتراضيّة في مواقع التواصل تتبنّى هذه الرؤى، وتقوّي جانب المجاهرة بها؛ فصارت -وهنا المربط- وسيلةُ تحقيق المكانة -بعد اختراب المعايير- هي: نشر الخَنَث على تويتر.
ولمّا انقسم المجتمع، إلى مستسمك بالأصالة، وإلى عبْدٍ مؤلّه للغرب؛ انقسمت فيه معايير المكانة؛ فكانت مكانةٌ عند قوم: انحطاطًا عند آخرين، والمرء يختار أيّ القومين يريد؛ مثلما يفعل عبيد الغرب هؤلاء، حين يضحّون بمكانتهم عند المجتمع؛ لأجل مكانةٍ عند المراهقات.
والمحصّلة: أنّ معايير هؤلاء في تحقيق المكانة قد اختربت، وقد أرادوا تحقيق المكانة؛ فكان العبيدُ، وكانت الرتاويتُ والتفضيلات.
-تمّت-
جاري تحميل الاقتراحات...