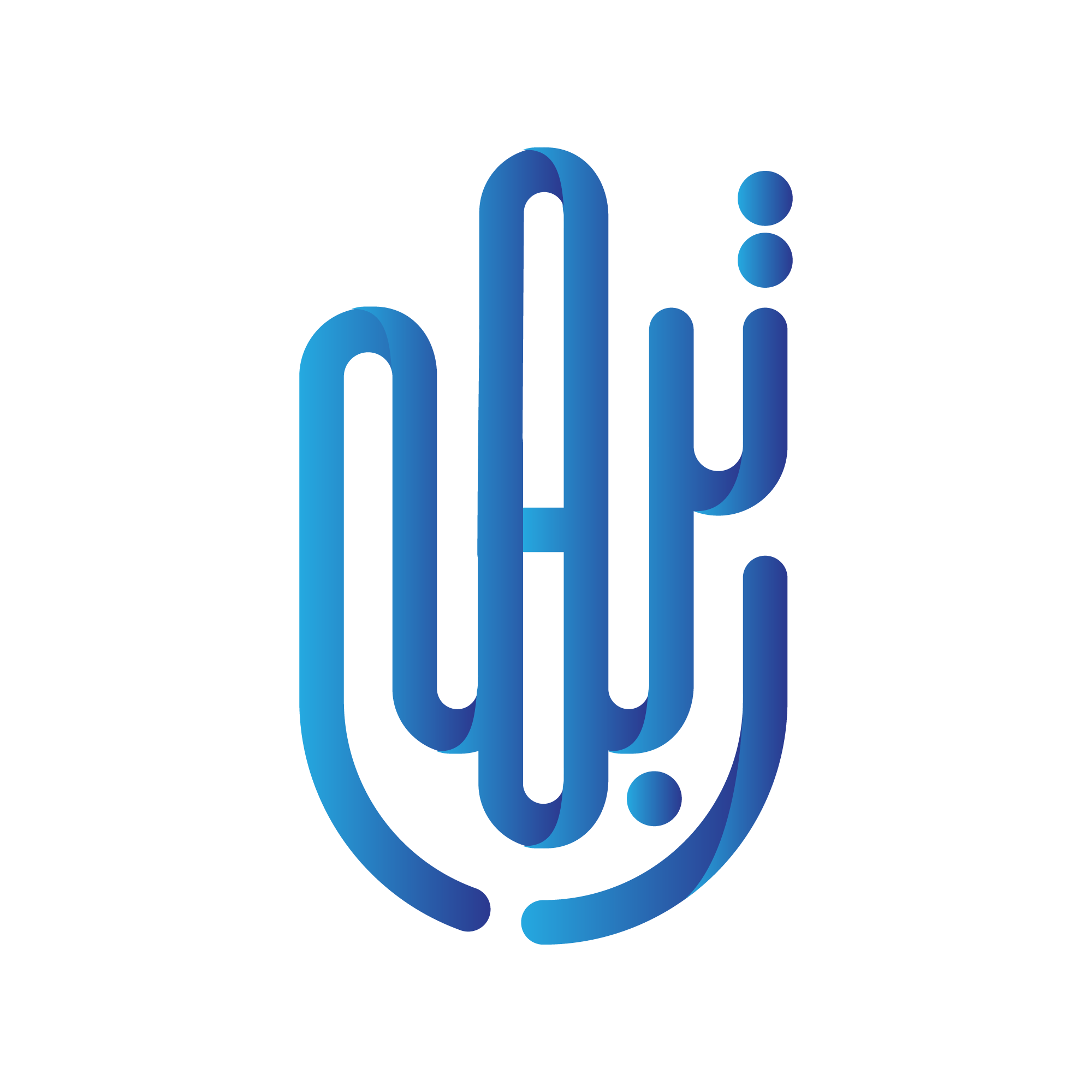كنت أجد متعة في تصور مقدار انبهار النابغة الذبياني بمظاهر الحضارة والتنعم عند الغساسنة ملوك الشام من العرب ، والتي ضمنها قصيدته البديعة :
كليني لهم يا أميمةَ ناصبِ ••• وليلٍ أقاسيه بطيء الكواكبِ
كليني لهم يا أميمةَ ناصبِ ••• وليلٍ أقاسيه بطيء الكواكبِ
والتي يقول فيها يصف تنعم الغساسنة :
رقاق النعال ، طيبٌ حُجُزاتهم ••• يُحيّون بالريحان يوم السباسب
تحييهمُ بيضُ الولائد بينهم ••• وأكسية الإضريج فوق المشاجبِ
يصونون أجسادا قديما نعيمها ••• بخالصة الأردان خضر المناكب
رقاق النعال ، طيبٌ حُجُزاتهم ••• يُحيّون بالريحان يوم السباسب
تحييهمُ بيضُ الولائد بينهم ••• وأكسية الإضريج فوق المشاجبِ
يصونون أجسادا قديما نعيمها ••• بخالصة الأردان خضر المناكب
فقد أدهشت هذا البدوي من بدو الجاهلية ( النابغة ) مظاهر الرفاهية لدى الغساسنة ، فوقف منها موقف المبهور بها المستعجب منها ! وأخذ يذكر منها لقطات سريعة ، وكأنها لقطات فوتوغرافية عجلى لتلك الحياة المترفة في بلاط الغساسنة ، ما أن يلتقط لقطة منها ، حتى تبهره الأخرى .
فانظروا إليه يصف نعالهم ! نعم نعالهم! فهي نعال رقيقة!!
ورغم ما ذُكر من كون رقة النعل كناية عن كونهم لا يستعملونها للمشي الكثير وللخدمة، فإن صح ذلك، وإذا لم يكن وصفا لرقة النعل كناية عن الترفه مطلقا، لأعرابي عرف الاحتفاء أكثر من الانتعال ، قبل مجالسة الملوك ( المناذرة والغساسنة )،
ورغم ما ذُكر من كون رقة النعل كناية عن كونهم لا يستعملونها للمشي الكثير وللخدمة، فإن صح ذلك، وإذا لم يكن وصفا لرقة النعل كناية عن الترفه مطلقا، لأعرابي عرف الاحتفاء أكثر من الانتعال ، قبل مجالسة الملوك ( المناذرة والغساسنة )،
ولا عرف الانتعال إلا بأبشع وأغلظ صورة ، لو ضربت بالنعل منها رأس جمل لانفلق ! فإذا به يجد نعالا ناعمة رطبة ، يُتزين بها ، وتُلبس للنعيم ، لا للوقاية من حصا الحرار ومن لسع العقارب ولدغ الحيايا !!
فيبقى أن كنايته عن التنعم بهذا الوصف دالة على أن هذه النعل قد استوقفته ، ورآها تستحق الكناية بها عن ترك المشي الطويل للشغل والعمل والخدمة !!
ثم يأخذه مشهد آخر من مشاهد النعيم في أجساد الغساسنة ، وهو أن ( حُجزاتهم ) وهي موضع ربط الحزام من البطن موصوفة بأنها طيبة : من الطيب والريح المستحسن .
فقد عرف هذا البدوي هذا الموضع من الأعراب : فهو من أقذر موضع في البشر ( لا أراه الله عزيزا لديكم) ، يشد عليه الأعرابي بحبل من ليف نخل أو من صوف غليظ ، ثم لا يبقى شيءٌ بخطر على البال إلا وتجمع تحته ، فأطيب ما يجتمع فيه وتحته قتر التراب وسواد الغبرة ،
ويختلط هناك بصبابة من عرق الأعرابي، وبما يتساقط فيه من طعام وشراب ، حتى يصبح شيئا لا تود أن تسمع عنه، فضلا عن أن تراه ، لا يشبه من وجه حجزات ملوك الغساسنة، في بياضها، وتحت ناعم ثيابها، وفي حماماتهم الشامية التي لا تدع من درن الجسم وآثار تعرقه إلا قطرات اللؤلؤ تتقاطر من الجنبين !
لا تكاد تتساقط حتى تمر على إثار العود الهندي في الجسد ، وبقايا الطيب في النحر والصدر ، فلا يزداد بها الجسد إلا طيبا .
وقيل : انه كنى بطيب الحجزات عن العفة ، وعدم ارتكاب الفواحش !
وقيل : انه كنى بطيب الحجزات عن العفة ، وعدم ارتكاب الفواحش !
ثم لما ذكر الطيب تذكر محفلا من مشاهد الطيب المشهودة ، فالقوم لا تتنفس أنوفهم غير الطيب ، ففي أحد أعيادهم النصرانية ، لا يحييهم الناس إلا بالرياحين . والريحان ليس هو فقط النبتة المعروفة اليوم بالريحان ، بل هو كل ما كان لساقه وورقه رائحة طيبة فواحة .
وهنا يستحضر الشاعر احتفال الأعراب بالعصي والرماح ، فإن تنعموا فبجريد النخل ! أين هذا من عرس الطيب الذي يحتفل فيه الغساسنة في بلاد الشام ؟!
ثم يستوقفه مشهد الأيدي التي ترفع الرياحين ، إنها في بياض الثلج ، وبضاضة اللؤلؤ ، إنها أيدي الصبايا في نضرة الشباب الأول ( الولائد ) ،
ثم يستوقفه مشهد الأيدي التي ترفع الرياحين ، إنها في بياض الثلج ، وبضاضة اللؤلؤ ، إنها أيدي الصبايا في نضرة الشباب الأول ( الولائد ) ،
ثم تظهر وجوههن كفلق القمر ليلة البدر ، قد زاد النعيمُ من نعيمهن الخلقي ، فصرن فتنة للنعيم ، ودواء للكئيب ، وفرحة للمصاب !!
وتذكر عفاريت الأعراب وهم يتقافزون في احتفالهم ،
وتذكر عفاريت الأعراب وهم يتقافزون في احتفالهم ،
فإن هبطت بينهم امرأة تلعب بشعرها المنشور ، كانت كأنها جنية ، قد لا ينقصها حسن الخلقة ، لكن الشمس لفحتها حتى أحرقتها ، وجفف رُواءها غلظُ العيش ، وأما سفوف الغبار وسُخام القدور فلونها بألوان التلفزيون يوم كان أبيض وأسود ، بلا ألوان .
ثم فجأة ينتقل هذا الأعرابي لمشهد ما كان لغيره أن يستوقفه ، وهو : منظر الثياب الحمراء وهي معلقة فوق المشاجب ، وهي ما نسميها اليوم بالشماعات ( أعواد تعليق الثياب التي تقف دون تثبيت في الجدار ) !!
وأكسية الإضريج : هي ثياب رقيقة جدا ، مصنوعة من خيطين : خيط حرير وخيط قطن ، وقد يستبدلون القطن بالصوف الناعم ، وهذا هو الخز الأحمر .
فيالهول ما رأى هذا الأعرابي : الثياب معلقة على أعواد !!!
فيالهول ما رأى هذا الأعرابي : الثياب معلقة على أعواد !!!
ومتى كان للأعرابي غير ثوب واحد ، لا يكاد يستره ! يتعرى ليغسله في كل رأس شهر أو شهرين أو أكثر . فإن كان له ثوبان طوى الآخر ، وأخفاه في حقيبة من صوف ، فيها يخفي خبزته وعذق تمره وربما ذراع شاة مشوية ، ويالفرحه لو تطيب ثوبه بزهم اللحم ودسمه .
أما أن تقف الثياب على الأعواد ، وأن تتبختر أنعم الثياب وأقناها لونا في هذا الوقوف المزهو المتبختر = فهذا نعيم ما كان يخطر على بال هذا البدوي !
والذي يدل على غرابة فكرة تعليق الثياب عند الأعراب ، أن أحدهم يصف مكتبة لأحد سادة قريش في زمن بني أمية ( عبد الحكم بن عمرو الجمحي ) ، وأنه : (( جعل في الجدار أوتادا ، فمن جاء ، علق ثيابه على وتد منها ، ثم جر دفترا ، فقرأه )) .
ثم يستحضر هذا الأعرابي أن هذه الثياب ليس الغرض منها ما يقصده البدوي من اللباس: ستر العورة ، والوقاية من الحر والقر ، لكي لا يموت . إن ثياب الغساسنة وقفت لهم ، لا لغيرهم ، لتصون أجسادهم التي لا تعرف غير النعيم ، ومن قدم نعيمها كاد هذا الأعرابي أن يجعله نعيما أزليا (قديما نعيمها).
ثم تأخذ بصره مرة أخرى ألوان هذه الثياب الرقيقة الحمراء ، باخضرار موضع الكتف منها إلى الرقبة ! حمرة وخضرة !! وهو الذي لا يعرف من الألوان في الثياب إلا لون وبر الإبل أو صوف الغنم !!
لقد استطاع هذا الأعرابي بوقفات انبهاره هذه أن يدخلنا بيوت الغساسنة في الجاهلية ، وأن يلتقط لنا صورا فوتوغرافية جميلة ومعبرة ، يستحق معها أن ينال جائزة أجمل صورة معبّرة في العالم !!!
جاري تحميل الاقتراحات...