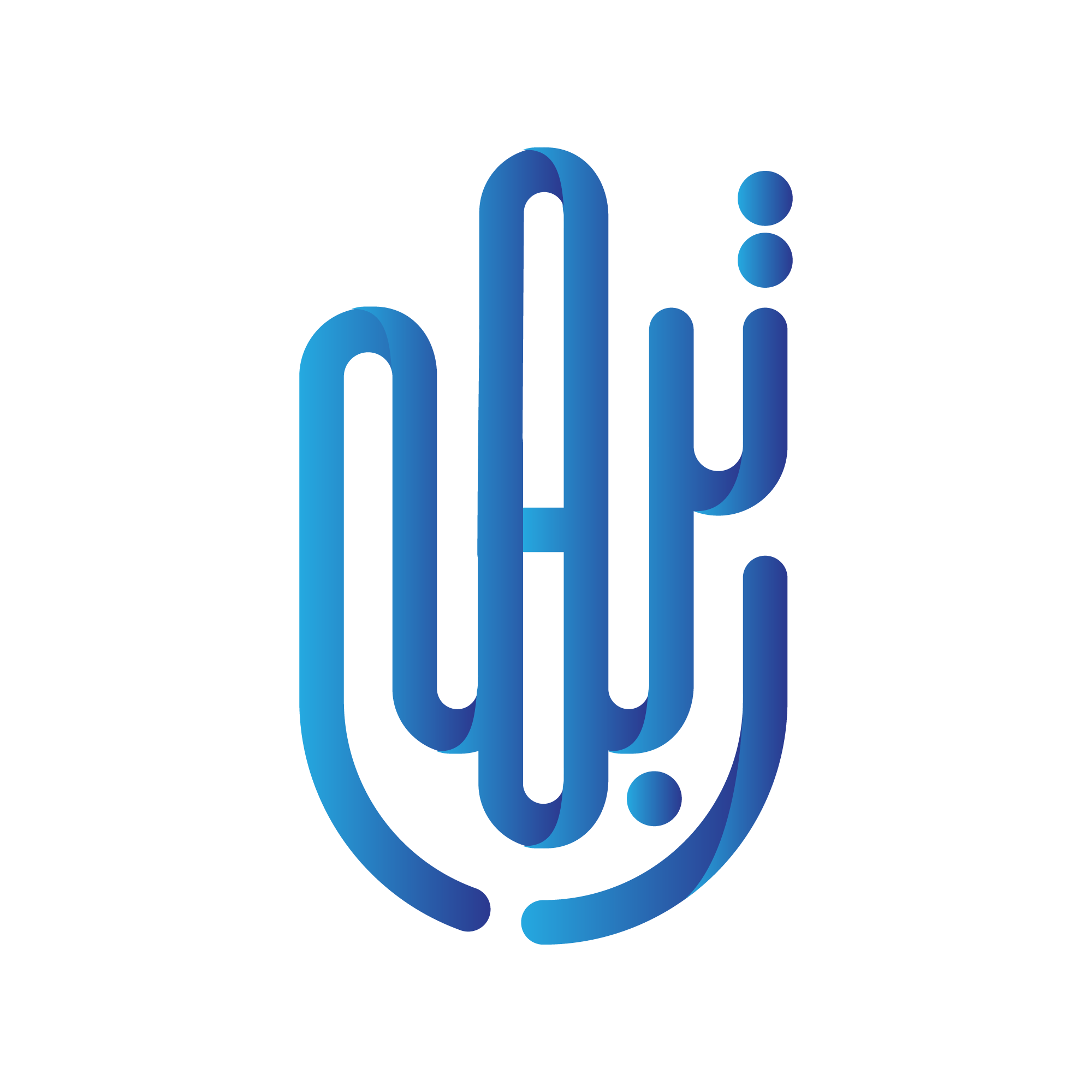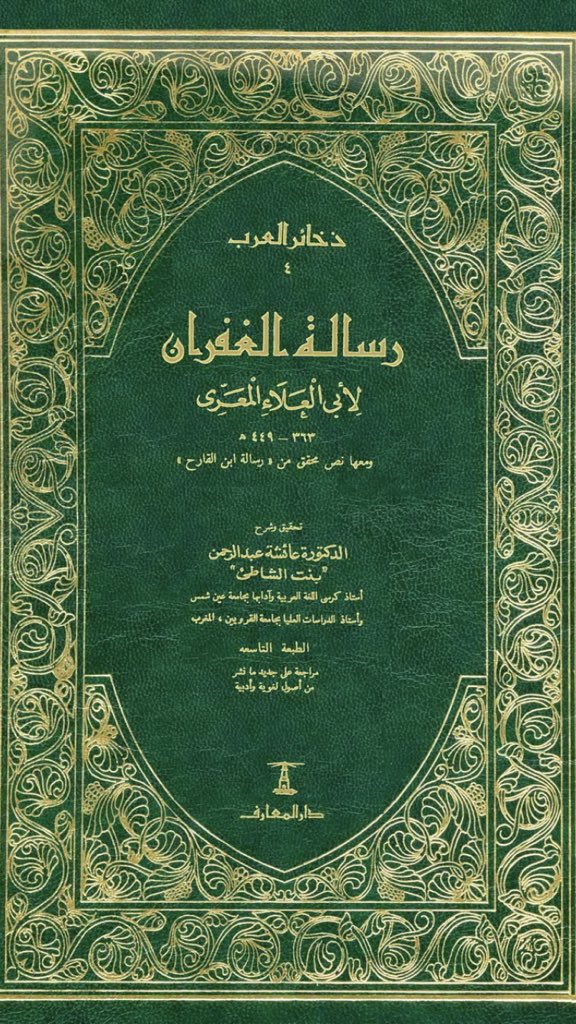لكن قبل أن أشرع في بيان ذلك، أحبُّ أن أجذم العُرى تمامًا بين رسالة الغفران والكوميديا الإلهية، وهي مسألة أثارها المستشرق أسين بلاثيوس قديما، ثم بقيت تتردد بعده كلما ذُكر المعري أو ذُكرت رسالته، يخال من يرددها أنه يحسن صنعًا إلى أبي العلاء حين يجعل دانتي مدينًا له، بينما هو يضرّه.
فالذهاب إلى العالم الآخر، وزيارة الجنة والنار، ومحادثة الأموات، ثيمة تتشاركها الأمم، ما كان على دانتي إلا أن يقرأ الباب السادس من الإنياذة -ملحمة شاعره المفضل ڤيرجيل- لينهل من نفس الثيمة. ألم يتخذ ڤيرجيل دليلًا يقوده عبر الجحيم والمطهّر؟ وحسبك هذا شاهدًا على مدى تأثّره.
اقرأ الإنياذة، ستكتشف أنّ العالم السفلي الذي زاره إينياس؛ بنهره Acheron، وبربّانه Charon، وبوحشه ذي الرؤوس العديدة Cerberus، يكاد يكون الخارطة الأصل التي اعتمدها دانتي في بناء جحيمه، قل مثل ذلك في الحوارات التي تجري بين إينياس وموتى الإغريق، هي أشبه بروح الكوميديا من الغفران.
وما أذكى كيليطو حين قال: إنّ دانتي هو من أثّر على المعري وليس العكس! سترتبك وتسأل: كيف يؤثر لاحقٌ على سابق؟ ألم يأت دانتي بعد المعري بثلاثة قرون؟ لكنك ستلمح المفارقة بعد لحظات: إنّه يقصد طريقة تلقّينا للغفران، صرنا لا نقرأها إلا على ضوء الكوميديا، وهذا يغمطها حقها ويخفي ميّزاتها.
هناك فروقٌ جوهريةٌ بين العملين، لن تبصرها إلا بعد فصم العُرى، منها أنّ الكوميديا -بطبيعة انتمائها إلى عصر النهضة- مصممةٌ حسب معمارٍ هندسي دقيقٍ ومُسبق، كل مشهدٍ فيها يخضع لضبط حديديّ، لا شيء يجري صدفةً أو عفوَ خاطر، وهذا يحعلها كلاسيكية الطابع، ويزهق فسحة الحرية فيها.
أما رسالة الغفران فنقيض ذلك، لا أعرفُ عملًا في الأدب العالمي يتمتع بهذا القدر من الحرية والانشراح، ويكفي أنّ الجنّة التي بناها دانتي بالإزميل والمسطرة، انبعثت في الغفران من كلمة صدرت من ابن القارح، فإذا بشجرةٍ تنمو، وإذا بفروعٍ تعلو، وإذا بظلّها يأخذ ما بين المشرق والمغرب، =
وإذا بزمرة من الولدان المخلّدين يتفيئون ظلّها، وإذا نحن في الجنة دون أن نشعر! ستجد نفسك طيلة قراءتك الرسالة تتراجع القهقرى كي تتذكر كيف ومتى بلغت هذا الموضع. كم من عملٍ حديث يسعى جاهدًا كي يحرز مثل هذه التنقّلات فيخفق، ثم يأتي قوم يقولون إنّ أسلوب الغفران يحتاج إلى تحديث!
هناك فرقٌ آخر ينساه كثيرون: الكوميديا عملٌ مستقلّ يُقرأ مُفردًا، بينما الغفران تتعلّق برسالةٍ سبقتها بعث بها أديب يُدعى ابن القارح. لذا يجدر بالقارئ الحصيف أن يسأل نفسه: من ابن القارح هذا؟ وأيّ نوع من الرجال هو؟ وكيف وقعت رسالته في نفس أبي العلاء؟ ثمّ يأتي الفيل الذي في الغرفة =
-وهو تعبيرٌ يُستخدم للدلالة على مشكلة صارخة لا يُلتفت إليها عادة-: ألم يجد ابن القارح موضوعًا أنسب من الزندقة يكتب فيه إلى أبي العلاء؟ ألم يقرأ شيئا من لزومياته؟ ألم يسمع ما يُشاع حول عقيدته؟ لماذا خصص الجزء الأكبر من رسالته لمهاجمة الزنادقة؟ أتُراها سقطة وغفلة؟ أم تراه يعرّض به؟
قد تعترض قائلا: إنّ الشبهات التي أثيرت حول مُعتقد أبي العلاء لم تظهر إلا بعد وفاته، أمّا أثناء حياته، فلقد كان مهوى القلوب وقبلة المتأدبين، ألم يقف سبعون شاعرًا حول قبره؟ وهذا فيه بعض الصحة، غير أنه يقصر عن الحقيقة كاملة. تذكّرْ أنّ أبا العلاء حين أملى رسالة الغفران (سنة ٤٢٤ ه) =
كان قد فرغ من لزومياته قبلها بست سنوات على الأرجح، وهي مسألة حرّرها بروفيسور عبد الله الطيب في أطروحته البارعة "أبو العلاء شاعرًا". وكأي شيء يمليه أبو العلاء لا بدّ أنّ هذه اللزوميات ذاعت بين الناس، لا بدّ أنّ بعض أبياتها الشائكة أثارت حفائظَ ورفعت حواجبَ كما لا تزال تفعل الآن.
ألم يؤلف أبو العلاء رسالة للرد على من هاجم لزومياته؟ وحسبك شاهدا على ضراوة الهجمة والكَلَب الذي مورس ضده، عنوانه الذي اختاره للرد: زجر النابح! لا بد أن أبا العلاء حين قُرئت رسالة ابن القارح تساءل: هل الرجل يعرّض بي، أم هو نقي السريرة؟ هل توجد أفعى في رسالته، أم أنها رسالة بريئة؟
لا بدّ أنّ الرسالةَ قُرئت عليه غير مرة! ولو وضعتَ نفسك مكان أبي العلاء، وقرأت الرسالة بغية الحكم على صاحبها، لجزمت أنّ ابن القارح -رغم ما تدلّ عليه رسالته من تمكنٍ لغويّ وسعة معرفة- ساذجٌ خفيفُ عقل، فرسالته تحتوي مجموعَ سماتٍ وخصائصَ لا تتوافر إلا في ذوي الخفّة والغفلة.
فمن ذلك أنه متطاير الأفكار، يقفز من فكرة إلى أخرى على غير هدى، بعكس أبي العلاء الذي -مهما استطرد- لن تعدم رؤية الخيط الذي ينظم أفكاره سويًا. ومن ذلك أنه سيء الظن فيمن حوله، يتهم عديله بسرقة رحله، وابنة أخته بسرقة دنانيره، ثم لا يتوّرع عن شكواها إلى السلطان، وقد تكون سرقته فعلًا =
لكنّ المرءَ لا يعرض سوأة بيته أمام رجلٍ يكاتبه أول مرة! قل مثل ذلك في حديثه عن الخمر، وضعفه أمامها، وتخيّل موقع ذلك في نفس أبي العلاء، وهو من حرّم على نفسه الخمر واللحوم وأعرض بازدراء عن شهوات الدنيا. أما القرينة الحاسمة بخصوص ابن القارح، وأنّه لم يذكر الزندقة تعريضًا =
فذكرُه أنّه أنشأ رسالته بعد أن نما إلى علمه قول أبي العلاء وقد ذُكر عنده: "أعرفه خبرًا، هو الذي هجا أبا القاسم المغربي"، والمغربي هذا وليّ نعمته، ولذا خشي أن ينسبه أبو العلاء إلى الجحود ونكران الجميل، ومن يكتب معرّضًا لا يحفل كيف يراه من عرّض به. وابن القارح ليس بِدعًا من الناس =
فلو نظرت مليًا لتذكّرت عشرات من الناس يمتلئون ظَرفًا ولطفًا وحبًا للجمال والأدب، ثم إذا جلست إليهم لا تنقضي الجلسة إلا وقد كفّروا معاشرَ وزندقوا أقوامًا دون أن ينتبهوا أو تتحرّكَ فيهم شعرة! تشعر أنّ باعثهم في ذلك غفلتهم وخفّة أحلامهم وتماهيهم مع الرأي السائد، أكثر منه خبثَ طويّة.
فإذا بباب الجنة موصد دونه، وإذا به لا يدخلها إلا بشفاعة من الرسول ﷺ ، وإذا هو يصادف داخلها جماعةً من شعراء الجاهلية ممن اعتادت المخيلة الشعبية تصنيفهم ضمن أهل النار، كالأعشى والنابغة وزهيرًا وابن الأبرص وعدي بن زيد، ويكون سبب نجاتهم بيت شعرٍ قالوه، أو كلمة صدق أذاعوها.
ولكن كيف يتمكن أبو العلاء من إيصال هذه المعاني دون أن يثير تحرّز ابن القارح؟ سوف يتسلل إلى قلبه عن طريق ولعه باللغة، تمامًا كما فعل إبليسُ حين اختبأ في جوف أفعى كي يتسلل إلى شجر الجنة ومنه إلى قلب حواء. وهنا أرجع بك إلى الحماطة التي ما كانت قطّ أفانية، ولا الناكزة بها غانية.
عد إلى المقدمة، ستجد الأفعى والشجرة والقلب موجودة كلها في أول فقرة، ثم تتكرر تورية الأفعى والقلب في ثاني وثالث الفقرات، ويا لها من توريات ذكيّة مخاتلة تكاد تجسّم عناصر التلقي أمامك، لا تملك حين تقرأها إلا أن تستحضر إبليس، وتسلّله إلى الجنة، والأفعى، حتى وإن كانت محض إسرائيليات.
هل قصد أبو العلاء إلى الحماطة والأسود والحِضب بهذا المعنى أم جاء صدفة؟ لا أعلم! ولا يعنيني أن أعلم، فالنصّ صار قائمًا بذاته، طافحًا بالدلالة، وهذه التوريات المخاتلة من شأنها أن تسحر ابن القارح، وتبقيَه معلّقًا مخطوف اللبّ، إلى أن ينهيَ رحلته العجيبة ما بين المحشر والجنّة وجهنّم =
فإذا بمعنى جديد يتسلل متلصصًا حتى يخالطَ شغاف قلبه، وإذا به أكثر تسامحًا وهو لا يدري، وإذا به يؤمن أنّ الغفران مسألةٌ إلهية أدقّ وأجلّ وأخطر من أن يتطفل عليها بنو البشر، ومن هنا اكتسبت الرسالة عنوانها النبيل الذي لا أعرف له نظيرًا بين كتب العربية: "رسالة الغفران".
جاري تحميل الاقتراحات...