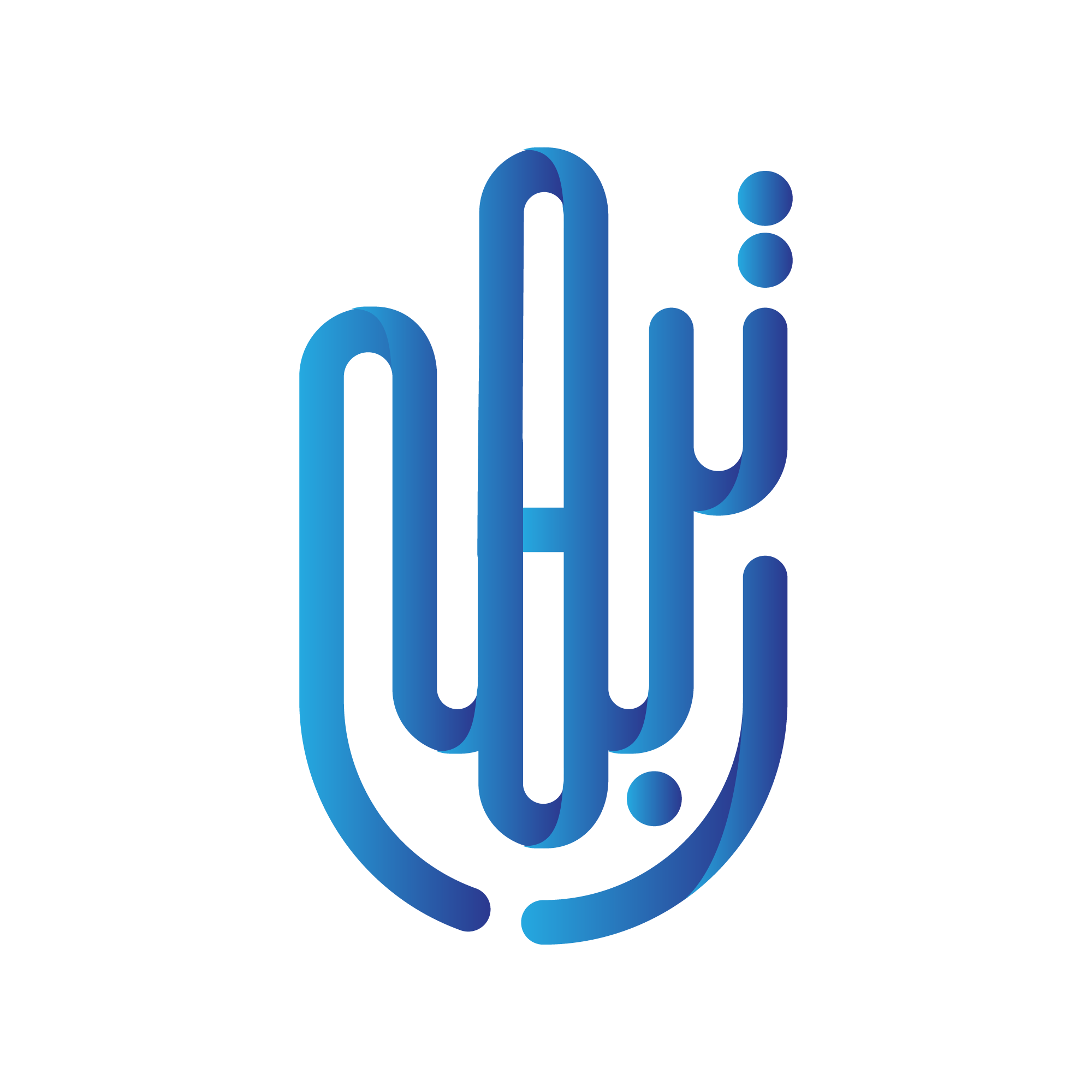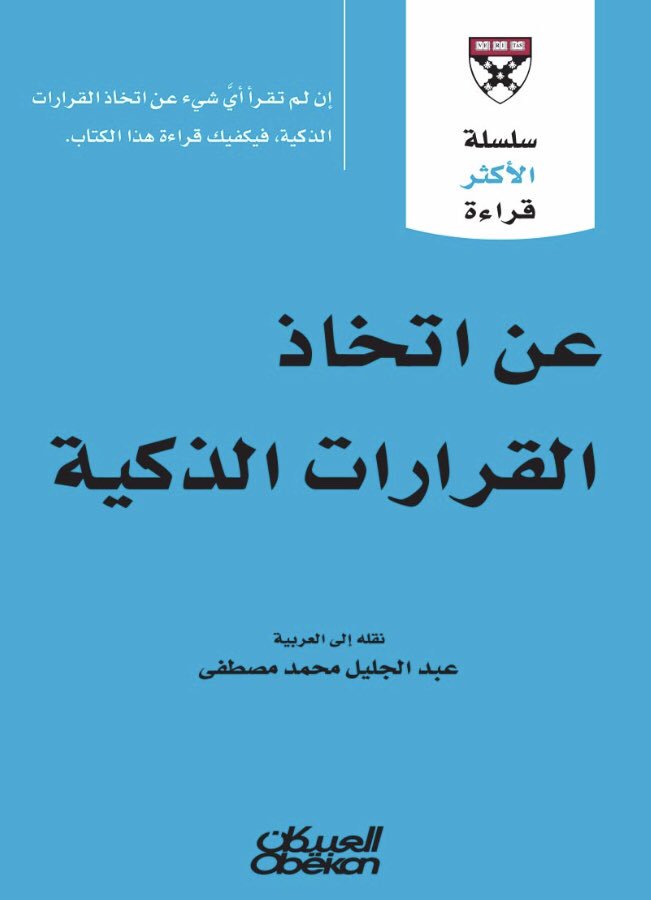عندما يُبحث في اتخاذ قرار ما فإن العقل يُعطي وزنًا غير متكافئ للمعلومات التي يتلقاها. فالانطباعات والتقديرات والمعلومات الأولية تستبد بالأحكام اللاحقة!
يُظهر صانعو القرار تحيّزًا قويًّا نحو "الوضع الراهن". ويمكن لمس هذا التحيز عندما يُطرح منتج جديد. فعندما طُرحت الصحف الإلكترونية أول مرة على الإنترنت كانت تشبه كثيرًا (في شكلها) سابقاتها من الصحف المطبوعة!
تعزز بعض المنظمات مصيدة "التكاليف الغارقة". فإذا كانت العقوبات الخاصة بصناعة قرار سلبي النتائج مفرطة في الشدة (التكاليف)، فإنه ستظهر لدى المديرين دوافع بترك المشروعات الفاشلة تستمر على ما هي عليه دون أن تلوح نهاية في الأفق!
تحيز "تأكيد الدليل" يختص بالكيفية التي نفسّر فيها الأدلة التي نتلقاها، الأمر الذي يدفعنا لإعطاء وزن كبير جدًّا للمعلومات الداعمة لوجهة نظرنا، ووزن قليل جدًّا للمعلومات المناقضة لها!
لأننا نعتمد بصورة متكررة في توقعاتنا بشأن المستقيل على أحداث الماضي، فإننا نبالغ في التأثر بالأحداث الدراماتيكية التي تركت انطباعًا قويًّا في ذاكرتنا.
قد لا نكون قادرين على التحكم في حدسنا (المتحيّز)، ولكننا نستطيع استخدام التفكير المنطقي لضبط حدس الآخرين وتحسين حكمهم على الأشياء!
لدى الناس استعداد تلقائي لإساءة تفسير الإخفاقات الصغيرة (في عمليات الأداء) أو تجاهلها. ولذلك غالبًا ما تمرّ دون تمحيص، بل وينظر لها على أنها جانب من المرونة، بينما هي مؤشرات نذير بحدوث كارثة أو أزمة!
هناك أمران يضيفان ضبابية على أحكامنا:
1- القبول بالأشياء الشاذة التي تنطوي على مخاطر على أنها أمر طبيعي،
2- التركيز على نتائج الأعمال أكثر من العمليات المعقدة التي أدت إليها.
1- القبول بالأشياء الشاذة التي تنطوي على مخاطر على أنها أمر طبيعي،
2- التركيز على نتائج الأعمال أكثر من العمليات المعقدة التي أدت إليها.
نادرًا ما يكون وراء الكوارث المؤسسية سبب واحد، إذ إنها ننيجة تفاعل غير متوقع بين أخطاء بشرية، وإخفاقات تكنولوجية، وقرارات سيئة، وظروف مؤاتية.
عندما يحدد المديرون الانحرافات (مشكلة في المنتج مثلا) فإن ردة فعلهم التلقائية غالبًا ما تتركز على تصحيح أعراض هذه المشكلة وليست أسبابها!
توجيه الأسئلة الصحيحة، وتحديد النزاعات وحلها، وتوفير تغذية راجعة أمينة وبناءة، والمفاضلة بين الموظفين عن طريق المكافآت والعقوبات ليست بالمهام السهلة.. لذا نجد أن كثيرًا من المديرين يتجنبونها متسببين بعجز المنظمة عن اقتسام المهارات وصنع القرارات ومجابهة الصراعات.
يأخذ الحوار أثناء عملية صنع القرار صورتين: أحدهما "الموضوعي" الذي يتعلق بجوهر العمل، والثاني "المتأثر" الذي ينتج من الاحتكاك بين المتحاورين.. الأول يُعدّ ضروريًّا لعملية صنع القرار، والثاني مدمرًا لها.
"النزاع الإدراكي" يرتبط بموضوع البحث. وهو ينطوي على خلافات بشأن أفضل الطرائق للمضي قُدمًا. ومثل هذا النزاع لا يتميز بأنه صحي فقط بل وضروري للتحقيق الفاعل (وصنع قرار أمثل).
توجد طريقتان لقياس صحة الحوار المؤدي لصنع القرار: نوعية الأسئلة التي تُطرح فيه، ومستوى إنصات أطراف الحوار بعضهم للبعض الآخر.
صناعة القرار لا تنتهي بظهور القرار الجيد، وإنما تنتهي بالتنفيذ. ويجب ألا يكون الهدف هو تحقيق الإجماع الذي غالبًا ما يشكّل عقبةً أمام العمل، بل يجب أن يكون الهدف هو الموافقة على القرار والالتزام بالتنفيذ.
التحيزات الخفية في صناعة القرار تمنعنا من التعرّف إلى الموظفين ذوي الإمكانات الفائقة والاحتفاظ بالموهوبين، بالإضافة إلى أنها تمنعنا من التعاون مع شركائنا بصورة فاعلة.
عادة ما يغالي الفرد بتقدير إسهاماته في فريق العمل، الأمر الذي يؤدي إلى نزعة بالشعور للاستحقاق.. وكلما زاد تفكير الفرد في إسهاماته فقط (دون إسهامات غيره) تراجعت النزاهة في أحكامه على العاملين معه.
المنظمات التي تتمتع بالجدية في مأسسة صناعة القرار غالبًا ما تعيّن خبراء قرارات ليعملوا مع المديرين على تحسين عمليات هذه الصناعة.
تستخدم "الأتمتة" في كثير من الأحيان بدلًا من صانعي القرار من البشر، لكن بالاستغناء عن العنصر البشري قد نجعل المنظمة في خطر الأخطاء، مما يستلزم وجود خبير بشري يراجع معايير القرارات ويتعرّف دوريًّا إلى نواحي الخلل في هذه "الأتمتة".
ينظر معظم المديرين إلى التخطيط الإستراتيجي التقليدي على أنه عديم الفائدة لسببين: الأول لأنه عملية تُنفّذ بصورة سنوية ولا تعينهم على الاستجابة السريعة للتحديات والفرص، الثاني لأنه يتناول كل وحدة من المنظمة على حدة، ولا يوفر معلومات كافية عن القضايا الملحة في المنظمة بشكل عام.
جاري تحميل الاقتراحات...